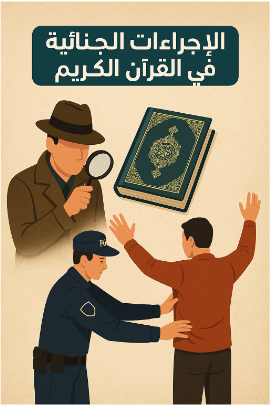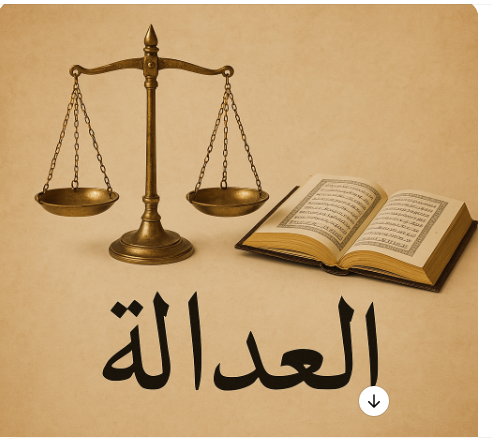مقدمة
ولما كان التفتيش من أشد الإجراءات مساسًا بحريات الأفراد وخصوصياتهم، فقد ران على قلوب كثيرين من الناس القلق والخوف من أن يتحول هذا الإجراء إلى وسيلة للقهر والتسلط، الأمر الذي حتمًا يستدعي الحرص التام على أن يبقى هذا الإجراء محاطًا بقيود قانونية تضمن عدم التجاوز على الحقوق. وفي حين كانت الشرائع السماوية قد أولت هذه القضية أسمى درجات الاهتمام، فقد وضع القرآن الكريم ضوابط صارمة تحمي الإنسان وتحفظ خصوصياته من أي انتهاك، فكان الاستئذان هو المبدأ الأسمى، إذ قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا” (النور: 27)، ولما كان الاستئذان علامةً من علامات الاحترام المتبادل، فقد حذَّر القرآن الكريم من التعدي على هذه الحريات، مُبينًا أن الأصل في الإنسان البراءة، وأنه لا يجوز النظر إليه بعين الشبهة إلا إذا كان هناك دليل قاطع على جريمة. وما انفك القرآن الكريم يحذر من التجسس ويمتنع عن أي نوع من التطفل على حياة الآخرين، مؤكدًا في قوله تعالى: “وَلَا تَجَسَّسُوا” (الحجرات: 12)، إذ كيف يليق بالإنسان أن يعمد إلى تتبع عورات غيره، في حين أن الله قد أمر بحفظ خصوصيات الناس وحقوقهم؟! فإن من يتعدى على هذه الحقوق يقترف جريمة عظيمة. ولئن كان التفتيش مشروعًا في حالات معينة استنادًا إلى الأدلة، فلا غرو أن يكون ذلك متروكًا للسلطة القضائية، التي تنظر في أمر التفتيش وتحدد مشروعيته. وفي المقابل، إذا كانت هناك قرائن تدعو لذلك، فلا حين غره أن يُمارس التفتيش بحذر وحسب، متجنبًا كل ما من شأنه أن يضر بالحرية الشخصية ويقيدها من غير وجه حق. تأمل في قوله تعالى: “إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ” (المائدة: 55)، حيث يشير النص القرآني إلى أهمية الحفاظ على حقوق الأفراد، بل ويُؤكد أنه لا يجوز انتهاك هذه الحقوق إلا في الحالات التي تستدعيها الضرورة القاطعة، مع الالتزام التام بالعدالة والإنصاف.
أولًا: الاستئذان قاعدة أصيلة قبل دخول البيوت والتفتيش
ولما كان القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزل للناس هدى ورحمة، فقد أرسى قاعدة عظيمة في حفظ حقوق الأفراد وكرامتهم، ألا وهي الاستئذان قبل دخول البيوت، وهو مبدأ راسخ لا يحيد عن العدل، كما قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ” (النور: 27). إذ كيف يمكن للإنسان أن يتجاوز هذا الحق الإلهي؟ كيف له أن يقتحم خصوصيات الآخرين دون إذنهم؟ أليس في ذلك ظلمٌ صارخ، وتعدٍّ على حدود الأمانة التي أمر بها الله؟ ولئن كان الاستئذان يعتبر عند البشر مبدأ اجتماعيًا، فإن القرآن الكريم قد جعله من أسس العدل الإلهي، ليفصل بين خصوصية الفرد وحقوق الآخرين، وليضع ضوابط واضحة لا تقبل الازدواجية.
ولما كان الأمر كذلك، ما انفك القرآن الكريم يشدد على هذه القاعدة، بل جعل الاستئذان فرضًا قبل دخول البيوت، كما في قوله تعالى: “فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ” (النور: 28). إذ كيف يُباح للإنسان اقتحام بيت غيره بغير إذن أو مبرر؟ ولئن كان في هذا التحذير الكوني المشرع، ما يُثبت أن التفتيش، في كل زمان ومكان، لا بد أن يُشترط فيه إذن قانوني صريح، بما يتماشى مع الحقوق الأساسية التي كفلها الإسلام للبشر.
إذن، لا غرو أن الاستئذان لا يُعدّ مجرد إجراء اجتماعي عابر، بل هو أصل جوهري يضبط العلاقة بين الناس ويضع أسس الاحترام والتقدير للخصوصيات. إذ كيف لا يكون الاستئذان هو الفاصل بين العدوان وبين الامتناع عن التدخل غير المشروع؟ ولئن تباينت القوانين الوضعية، فإن جوهر التشريع الإلهي في هذه الآية، يعكس الحق المطلق في حماية حدود الإنسان من التجاوزات، ليظل أصل العدل والتوازن حاضرًا في كل شأن من شؤون الحياة.
وفي هذا السياق، فإن التشريعات القانونية الحديثة، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، قد تبنت هذا المبدأ القوي، حيث لا يجوز لأي فرد أو جهة أن يُجري تفتيشًا إلا إذا كان مستندًا إلى قرار قضائي مسبب، ليحمي خصوصية الأفراد من أي تجاوز أو انتهاك غير مبرر. فالتفتيش وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لا يتم إلا بعد توافر أسباب معقولة، ووجود دلائل مشروعة على ارتكاب الجريمة، مما يطابق ما جاء في القرآن الكريم من ضرورة الحصول على إذن قانوني قبل اقتحام خصوصيات الناس. كما أن القوانين الوضعية تقرّ ضرورة إصدار أمر تفتيش من جهة قضائية مختصة، تتأكد من وجود مبرر قانوني يجعله إجراءً مشروعًا. فليس من حق أي جهة أو شخص أن يخترق حدود الآخرين بغير مبرر قانوني، وإن كان ذلك يشمل تفتيش المنازل أو أي حق آخر للإنسان.
إذًا، نجد أن المبدأ الذي أرسته الشريعة الإسلامية من خلال الآيات القرآنية المتعلقة بالاستئذان، يتماشى تمامًا مع القوانين المعاصرة التي تحترم حق الإنسان في الخصوصية، وتمنع التدخلات غير المشروعة، بما يعكس توافقًا بين العدالة الإلهية والعدالة الوضعية في حفظ الحقوق.
ثانيًا: النهي عن التجسس بوصفه انتهاكًا لحرمة الأفراد
ولما كان القرآن الكريم قد حظر التجسس، وأكد على حرمة الخصوصية، فقد أكد على ضرورة أن تكون جميع التصرفات المتعلقة بحقوق الأفراد، من دخول بيوتهم أو التفتيش في ممتلكاتهم، مشروعة بأدلة واضحة وقوية. حيث قال تعالى:”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا” (الحجرات: 12). تلك الآية الكريمة تمثل حجر الزاوية في ضمان حرمة الأفراد، فتدعو إلى الابتعاد عن الظنّ والتجسس الذي لا يستند إلى أي دليل قاطع، بل إلى مجرد افتراضات غير محققة. وهذا المبدأ القرآني يتماشى تمامًا مع الضوابط الحديثة للتفتيش المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية، حيث يُشترط أن يكون التفتيش مستندًا إلى أسباب قانونية واضحة وقرائن قاطعة تدل على ارتكاب الجريمة، ولا يجوز أن يكون تفتيشًا بناءً على ظن أو شكّ لا يتجاوز حد المظاهر الظاهرة. ففي قانون الإجراءات الجنائية، نرى أن التفتيش لا يتم إلا بموافقة القضاء، بناءً على طلب النيابة العامة، وأنه يجب توافر سبب قوي يدعو للتفتيش مثل وجود دلائل ملموسة أو تقرير من جهة مختصة. ولا يتم التفتيش إلا بقرار قضائي مسبب، مما يعكس تمامًا ما جاء في القرآن الكريم من ضرورة التحقق قبل الدخول إلى خصوصيات الأفراد. إذًا، فالقرآن الكريم يشير إلى قيمة عظيمة في حماية خصوصية الإنسان، ويُحظر أي تجاوزات تتعلق بها، بينما تؤكد التشريعات القانونية الحديثة، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، ضرورة وجود الأدلة الملموسة والضوابط القانونية قبل اتخاذ أي إجراء يطال خصوصية الأفراد. فكما أشار القرآن الكريم إلى أهمية تجنب الظن والتجسس، جاء القانون ليحمي هذه القيمة، محصورًا التفتيش في أضيق الحدود التي لا تضر بحقوق الأفراد.
ثالثًا: عدم اقتحام حياة الأفراد دون بينة قطعية
ولما كان التفتيش في جوهره مساسًا بحقوق الأفراد وحرياتهم، كانت الشريعة الإسلامية أول من وضع الأسس الثابتة التي تحمي الإنسان من الاستباحة والتعدي على خصوصياته. إذ إن القرآن الكريم، الذي جاء ليصون النفوس ويرسخ العدل، قد أرسى قواعد الاستئذان كأصل جوهري قبل دخول البيوت أو الشروع في التفتيش، وجعل ذلك مبدأ ثابتًا لا يجوز التنازل عنه. فها هو تعالى يقول: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا” (النور: 27)، وكأنما يُزجَّ بهذه الآية في الأذهان معايير من العدل لا تقبل التأويل، فكيف للمؤمن أن يقتحم خصوصية غيره دون استئذان؟ أليس في ذلك مثل الخرق في سفينة الأمن والطمأنينة؟! وهل من العدالة أن ينتهك الحق في الخصوصية لأدنى سبب أو شبهة، متجاهلًا ما كان ينبغي من احترام لحدود الأمانة وحُرمة النفس؟ لا غرو، فإن الاستئذان في القرآن ليس مجرد أمر اجتماعي، بل هو حجر الزاوية في بناء العدالة، ليكون فاصلًا بين ما يُباح وما يُحرم، بين ما هو محمي وما يمكن انتهاكه.
وفي ذات السياق، حيث إن الله سبحانه قد جعل هذا الاستئذان طوقًا من الأمان للناس، فقد جاء في قوله: “فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا” (النور: 28)، لتكتمل بذلك القاعدة الشرعية العميقة التي لا تقبل التهاون. فكما لا يُقبل اقتحام البيوت دون إذن، فإن الاقتحام القسري للمجال الخاص أو التفتيش من دون مبرر شرعي يُعد خرقًا فاضحًا لحرمة الإنسان. أترى أن الالتزام بهذا الأصل الإلهي يعد أمرًا ثانويًا؟! لا، بل هو الركيزة التي ينبغي أن تقوم عليها كل القوانين العادلة، سواء كانت تلك التي تنبثق من كتب السماء أو تلك التي استقر عليها العقل البشري في سبيل بناء نظم قانونية تكفل الحقوق.
وفي هذا الإطار، نجد أن التشريعات الجنائية الوضعية قد نهجت ذات النهج، فكما يُشترط في التفتيش أن يكون بناءً على قرار قضائي مؤسس على أدلة مادية دامغة، لا مجرد شكوك أو ظنون زائفة، نجد في القرآن الكريم تأصيلًا لهذا المبدأ عندما حذر من اتباع الظن: “وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ” (الإسراء: 36)، فكما لا ينبغي إيقاع الأذى بناءً على الظن، كذلك في قوانين التفتيش لا يجوز اتخاذ أي إجراء بناءً على شبهة واهية أو مجرد تخمين. فلا يُساق الإنسان نحو الإدانة إلا إذا كانت القرائن واضحة كالشمس في كبد السماء، فتكون حركته نحو التفتيش كالسهم الذي يمر في فوهة القوس مستقرًا في هدفه لا ينحرف عنه.
لا غرو في أن العدالة لا تُبنى على أساس الظن، إذ كيف يُساق الإنسان إلى محكمة التفتيش بناءً على شكوك غير يقينية، فتكون بذلك الحقوق مدعاة للتهديد؟ وهل يمكن التسليم بظن كالغيم الذي يعكر صفو السماء دون أن يكون له أصلٌ ثابت؟ إذ كيف يمكن أن تكون الشبهة والظن بديلاً للحقائق الثابتة التي لا تتغير؟ إن التفتيش، كأداة قانونية، لا يكون إلا إذا كانت الدلائل ملموسة، كما أن استباحة الخصوصيات لا تكون إلا في حال وجود دليل لا يقبل التأويل، بل يجب أن يكون مثل البصيص من النور الذي يضيء الطريق في ظلمة الليل.
والحقيقة أن التفتيش القائم على الظن، لا يمكن أن يكون محلاً للثقة في كل الأحوال، في حين أن التفتيش الذي يستند إلى الدلائل الصلبة كالصخر هو الذي يستحق الاحترام، ويستند إليه القانون. ومن هنا، يجب أن يُبنى التفتيش على يقين، لا على مجرد تصورات أو استنتاجات، كي لا تُنتهك الحقوق في غياهب الشكوك.
إذًا، كما أقر القرآن الكريم من ضرورة التمسك بالحق واليقين، يأتي قانون الإجراءات الجنائية في التشريعات الحديثة ليؤكد ذات الفكرة العميقة، فيكون التفتيش محاطًا بقيود لا يحق لأي جهة كانت أن تتجاوزها، لأن التفتيش بلا مبرر قانوني هو في جوهره خرقٌ لحرمة الإنسان، وإهدارٌ لحقوقه التي لا يجوز التفريط فيها.
رابعًا: ضرورة التحقق من الاتهام قبل اتخاذ الإجراءات القسرية
ولما كان التفتيش من أخطر الإجراءات التي تمس الحقوق والحريات، إذ إنه يتصل اتصالًا وثيقًا بحرمة الإنسان وخصوصيته، فقد جاءت الشريعة الإسلامية، جاعلة من التثبت والتبين قاعدة راسخة، فلا يجوز أن يُبنى الإجراء على مجرد الظنون والأوهام التي لا تغني من الحق شيئًا، بل لا بد من استيثاقٍ لا يشوبه الارتياب، وإلا كان الظلم أقرب من العدل، والجور أسبق من الإنصاف. ولا غرو أن القرآن الكريم قد قرر هذا المبدأ بأبلغ بيان، فقال جل شأنه: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” (الحجرات: 6)، أفلا ترى أن في ذلك تحذيرًا صارخًا من مغبة التعجل في اتخاذ الإجراءات دون دليل قاطع، خشية أن يقع العبد في مهاوي الجهل والندم؟!
ولئن كان هذا المبدأ ثابتًا في أحكام الشريعة، فما انفكت القوانين الجنائية الحديثة تحذو حذوه، فاشترطت أن يكون إذن التفتيش مبنيًا على تحريات جدية وأدلة قاطعة، لا أن يكون وليد إشاعات مغرضة أو اتهامات واهية، إذ كيف يجوز أن تُنتهك الحرمات دون أن يكون هناك بينة ساطعة، كالشمس في رابعة النهار؟! بل إن اشتراط القرينة القاطعة قبل الإذن بالتفتيش لا يختلف عن القاعدة التي قررها القرآن حينما قال: “وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا” (الإسراء: 36)، إذ كيف يُسمح للإنسان بالخوض في ما لا علم له به، فيقع في براثن الظلم والتعدي؟!
وكما أن الماء الطهور لا يقبل النجاسة، فكذلك العدالة تأبى أن تختلط بالظلم، فلا ينبغي أن يكون التفتيش إلا محاطًا بضمانات تحفظ للأفراد كرامتهم وتصون حقوقهم، فلا يباح إلا إذا كان قائماً على دلائل جدية لا تقبل الجدل، كما أن القاضي لا يُصدر حكمه إلا إذا قامت الحجة أمامه ثابتة لا يتطرق إليها شك. ولعل أعظم ما يُستشهد به في هذا المقام قوله تعالى: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ” (النساء: 58)، إذ كيف يكون الحكم بالعدل إن لم يكن قائماً على اليقين، وكيف تؤدى الأمانات إن كان التعدي على الحريات يجري بغير بينة؟!
ولئن كان بعض الفقهاء قد شبهوا العدالة بالميزان، فإن ميزان العدالة لا يستقيم إذا ران على القلوب صدأ الظلم، ولا يستوي الظل والعود أعوج، إذ كيف يُتوخى الإنصاف في بيئة تسيطر عليها الظنون ولا تحكمها الأدلة؟! ومن ثم، فإن التشريعات الحديثة، إذ تحظر التفتيش التعسفي، إنما تؤكد على ما قررته الشريعة منذ الأزل، بأن الأصل في الإنسان البراءة، فلا تنقض إلا بحجة قاطعة، وإلا كان الأمر أشبه بمن يطارد السراب، يظنه ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا.
خامسًا: إقامة البينة كشرط أساسي قبل الاتهام والتفتيش
ولما كان الأصل في الإنسان البراءة، إذ إنه لا يُصار إلى الاتهام إلا ببينة قاطعة، فقد قرر القرآن الكريم هذا المبدأ في أبلغ عبارة، حيث قال جل شأنه: “قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ” (البقرة: 111). إذ كيف يسوغ أن يُحمَّل الإنسان جريرة اتهام لا دليل عليه، أو أن يُعرض للتفتيش لمحض شبهة لا تستند إلى أساس متين؟! لا غرو أن هذه القاعدة القرآنية قد غدت اليوم قاعدة دستورية أصيلة، تقر بها جميع القوانين الحديثة، مؤيدة أن كل إجراء يمس الحريات لا بد أن يقوم على دليل ساطع، وإلا كان ذلك ضربًا من العبث وانتهاكًا صارخًا لحقوق الأفراد.
ولئن كانت البينة في الشريعة هي الفيصل بين الادعاء والبراءة، فقد جاء قانون الإجراءات الجنائية موافقًا لهذا الأصل، إذ اشترط لصحة التفتيش أن يكون مستندًا إلى دلائل قوية لا تقبل الشك، ولم يجز أن يُبنى على محض الظنون التي لا تغني من الحق شيئًا. إذ كيف يُباح للمحقق أن يقتحم حرمة البيوت أو أن ينتهك خصوصيات الأفراد بلا مستند مشروع؟! أتراه ينسج التهم كما ينسج العنكبوت بيته، واهنًا لا يقوى على الصمود؟!
وكما أن العدالة لا تُبنى إلا على أساس من اليقين، فكذلك التفتيش لا يكون مشروعًا إلا إذا استقام على برهان، وإلا كان كمن يخبط خبط عشواء، لا يهتدي إلى سبيل قويم. ولعل من أعظم ما يُستشهد به في هذا السياق قول الله تعالى: “وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ” (فاطر: 19-20)، إذ كيف يتساوى تحقيقٌ يستند إلى أدلة دامغة مع آخر قائم على الأوهام؟! بل كيف يُقر العدل في أمة إذا كان التفتيش يجري بغير ميزان، لا يزن الحقائق ولا يفرق بين الصدق والافتراء؟!
إذ ذاك، كان لا بد أن يحيط القانون إجراءات التفتيش بضمانات صارمة، فلا يتم إلا بإذن قضائي مُسبب، مستند إلى قرائن جدية تدل على وجود الجريمة، وإلا كان ذلك افتئاتًا على الحريات، وظلمًا بواحًا لا يسع العدالة أن تقره. وكما أن الماء الزلال لا يختلط بالكدر، فكذلك العدالة لا تُبنى على الظنون، بل لا بد أن تقوم على حجج ناصعة، تنأى عن كل شبهة، ليظل الحق ثابتًا لا تهزه الأهواء ولا تعصف به الشبهات.
سادسًا: العدالة في تطبيق القانون وعدم التحيز
ولما كان العدل هو الميزان الذي تُوزن به الحقوق، إذ إنه لا يستقيم نظام، ولا تستقر أمة، إلا إذا سار في دروب الإنصاف، فقد جاء القرآن الكريم آمرًا بالعدل المطلق، لا يحابي قريبًا، ولا يجور على بعيد، فقال جل شأنه: “وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ” (الأنعام: 152). إذ كيف يُرتجى استقامة حال إذا فُتح باب التحيز، وأُطلق العنان للهوى ليحكم في مصائر الناس بلا قسطاس مستقيم؟!
ولئن كان العدل في القول واجبًا، فهو في الإجراءات الجنائية أوجب، إذ إن التفتيش من أخطر الإجراءات التي تمس الحرية الشخصية، ومن ثم لا غرو أن يكون مشروطًا بأن ينصبَّ على من قامت ضده أدلة جادة، لا أن يكون ضربًا من الاستهداف العشوائي، أو وسيلة للتضييق على فئة بعينها بغير موجب مشروع. أتراه عدلًا أن يُفتش البريء كما يُفتش المشتبه به؟! أم يُعقل أن تُطلق يد السلطة في تفتيش من شاءت، متى شاءت، بغير قيد أو ضابط؟!
إذ كيف يكون التفتيش أداةً لإحقاق الحق، إن كان يُمارس بانتقائية، لا تحكمها قرائن واضحة، ولا تضبطها معايير الإنصاف؟! إن ذلك لعمري، أقرب إلى الظلم منه إلى العدل، إذ يشبه من يطفئ نور الشمس عن قوم، ويضيئه لآخرين، بلا مسوغ ولا برهان.
ومن هنا، لم تبح القوانين الجنائية الحديثة أن يكون التفتيش مطلق العنان، بل قيدته بضوابط صارمة، تمنع أن يكون أداة انتقام، أو وسيلة ضغط، فأوجبت أن يكون مبنيًا على إذن قضائي صريح، وأن يكون مسببًا، موجهًا إلى شخص محدد، لا إلى دائرة مبهمة، أو جماعة مستهدفة بلا مبرر.
ولعمري، إنما يكون القانون عادلًا إذا صان الحقوق، وجعل العدالة كالشمس لا تحجبها الغيوم، لا أن يكون سيفًا مشرعًا، يضرب من شاء، ويصفح عمن شاء، بلا ميزان قسط، ولا برهان عدل.
خاتمة
وإذ قد تبين لنا أن التفتيش، بما ينطوي عليه من مساس بالحريات، لا يجوز أن يكون مطلق اليد، ولا أن يُترك لعصف الرياح تتقاذفه كيف تشاء، فإن القواعد التي قررها القرآن الكريم جاءت سدًّا منيعًا، تصون الحرمات، وتضبط الإجراءات، فلا يكون التفتيش إلا بحق، ولا يُنفذ إلا بقيود صارمة، حتى لا يصبح أداة جور، أو مطية للعبث بكرامة الإنسان.
وما انفك التشريع الإلهي يؤكد على أن العدالة لا تقوم إلا على ميزان دقيق، فإن هي اختلّت، اختل معها نظام المجتمع برمّته، وإن هي جارت، غدت الحقوق نهبًا للهوى، واستحالت السلطة إلى وحش كاسر لا يبقي ولا يذر. فأتُرى يكون العدل عدلًا إذا لم تحرسه الضوابط؟ أتراه يكون ميزانًا قويمًا إذا لم تقم له قواعد تمنع الميل والانحراف؟!
إن القوانين الوضعية، على تقدّمها، لم تأتِ بجديد في هذا الباب، بل سارت في ظل التشريع الإلهي، تقرر ما قرره، وتؤكد ما أسّسه، فكان إذن التفتيش في صلبها مشروطًا، لا يُمنح إلا بإذن قضائي مسبب، ولا يُمارس إلا ضمن حدود صارمة، تمامًا كما أرسى القرآن مبدأ البرهان، فقال جل شأنه: “قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ” (البقرة: 111)، وحظر الظن والتجسس بغير حق، إذ قال: “وَلَا تَجَسَّسُوا” (الحجرات: 12).
ولئن كان العدل هو النور الذي تتبعه الأمم، فإذ ذاك لا يكون القانون أداة قمع، بل ميزانًا تُحفظ به الحقوق، وتُحمى به الحريات، فإنما العدل في أصله ميزان وضعه الله، لا يميل بسلطان، ولا ينحرف بهوى، ومن رام تحريفه، ارتد عليه ظلمه، كَمَثَلِ “الَّذِينَ تَنَازَعُوا فِي أَمْرِهِمْ” (الكهف: 21)، فتفرقوا شيعًا، وأضاعوا أنفسهم قبل أن يضيعوا غيرهم.
فلا غرو إذن أن تظل القواعد التي قررها التشريع الإلهي هي المنارة التي يُهتدى بها، فإن كانت القوانين الوضعية قد خطت نحو هذه المبادئ، فإنما هي تقتفي أثر تشريع سبَقَها، وميزان وُضع منذ الأزل، ليكون العدل أساس الحكم، والحرية مصونة بأمر الله، والتفتيش محاطًا بسياج حصين، لا يُخترق إلا بحق مبين، وإلا كان طغيانًا، يردي صاحبه قبل أن يفتك بغيره.