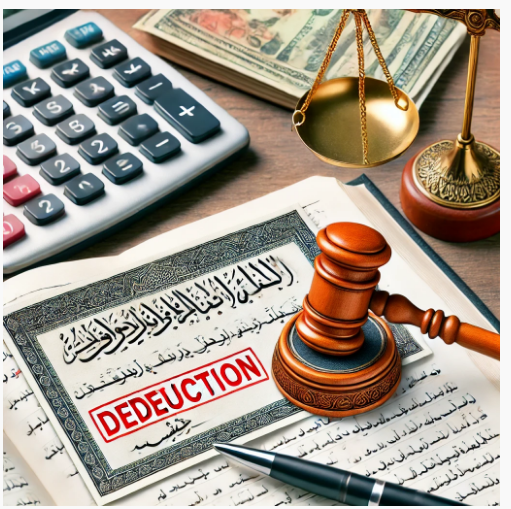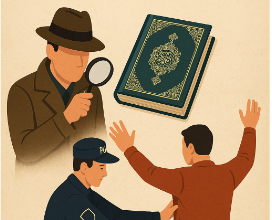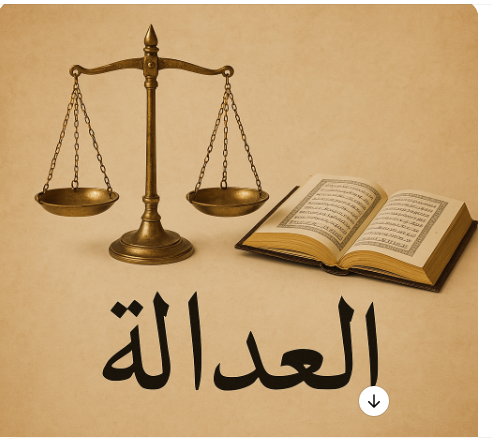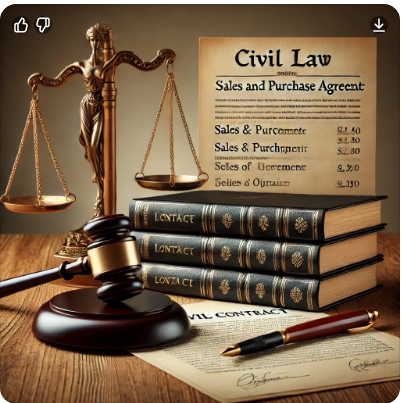مقدمة:
ما بين رفرفة الأعلام فوق الساريات، وعلوّ المعاني التي تنسجها خيوطها في الأفق، يُولَد معنى الوطن كما يُولد الفجر من رحم الظلمة، ويُغرس الانتماء في الأفئدة كما تُغرس البذور في تربٍ طهورٍ فتُزهِر ولاءً وشموخًا.
ولما كان العلمُ ليس رقعةً من قماشٍ تُلوَّن أطرافُه بألوان ثلاث، بل هو – لعمري – آية السيادة، ومَجلى الكبرياء الوطني، وعنوان الدولة بين الأمم، اتخذته الشعوب رايةً تُرفَع وقت السلم، وتُستَشهد دونه في الحرب، وتُبذل الأرواح دفاعًا عن قدسيته حين يُدنَّس أو يُهان.
أتراه في بساطته قطعة قماش؟ كلا وربي، بل هو تجسيدٌ صامتٌ لهوية الأمة، وشعارٌ ناطقٌ بعزّتها، ومرآةٌ تُطلّ منها كرامتها وهيبتها. ولا غرو، فالعلم عند الشعوب الحرة كالعقيدة لا يُنتقص منها، وكالشرف لا يُطال بسبابٍ ولا يُمتهَن بإهانة.
وإنه في حين تُقدّس الأمم رموزها، وتُغالي في الدفاع عنها، فإن من تسوّل له نفسه الاعتداء على علم وطنه، إنما يطعن في قلب الدولة، ويهدم في الوجدان ما شيّدته الأجيال من عزة واعتزاز. وما انفك العلم – منذ رفعته الأيادي الأولى – رايةً للهُوية، وجُندًا للمعنى، وسفيرًا صامتًا يلوّح في الآفاق أن هنا دولةٌ لا تُداس كرامتها، ولا تُهان رموزها.
فلأجل هذه العلّة الجليلة، وهذه المعاني المتجاوزة للملموس والمحسوس، قرر المشرع المصري أن يُحيط هذا الرمز المقدّس بسياج من الحماية القانونية، وأن يُنزّل على من يُهينه عقوبات صارمة، تُذَكِّر العابثين أن كرامة العلم من كرامة الدولة، وأن النيل منه لا يُعَد فعلًا عابرًا، بل خيانةً رمزية لا تُغتَفر.
أولًا: تعريف العَلَم لغويًا واصطلاحيًا
لما كان لكل أمةٍ رايةٌ تلوذ بها، وتُعلي بها صوت وجودها بين الأمم، اتخذت من العلم رمزًا جامعًا يُجسِّد كيانها ويُترجم هيبتها في عيون العالمين.
لغةً، العَلَمُ – بفتح العين واللام – مشتقٌّ من مادة “عَلَمَ”، وهي أصلٌ في العلامة والدلالة، يُقال: عَلَمُ الأرض، أي ما يُستدلّ به على معلمها، كما يُقال: هذا عَلَم الجيش، أي رايته التي تُميّزه وتُهتدى به في خضمّ المعارك وازدحام الصفوف. وقد ورد في “لسان العرب” أن العَلَم هو “الراية التي يُعرف بها الجيش”، والجمع “أعلام”، كأنها شواهد الوجود، وألسنة الصمت التي تنطق بالانتماء والولاء.
ولا غرو أن العَلَم – وإن بدا قماشًا مرفرفًا – إنما هو في أعماق الوعي الجمعي كيانٌ رمزيٌّ تستقرّ فيه معاني النصر، وتنبعث منه إشارات المجد، وتتكثّف في ألوانه حكايات الشهداء والرايات المرفوعة فوق جباه الفخر.
أما اصطلاحًا، فالعلم هو شارة السيادة وسِمَة الدولة، وشعارها العلنيّ الذي تُعرَف به في المحافل الدولية وتتميّز به عن سواها من الدول. وهو – في جوهره – لسانٌ صامت يُعبّر عن تاريخٍ عميق، وحضارةٍ متجذّرة، وسلطانٍ معترف به دوليًا، تُحنى له الرؤوس في الجيوش، وتُرفع له الأكفّ في الأناشيد الوطنية، ويُلتفّ حوله في الأزمات كما يُلتفّ حول الجمر في ليل الشتاء.
فهو ليس مجرد شكلٍ هندسيٍّ أو طيفٍ لونيٍّ، بل هو اختزالٌ بصريٌّ لكل ما يُعبِّر عن الدولة، من تاريخها، وسلطتها، وعقيدتها السياسية، إلى تطلعاتها في الحاضر والمستقبل. وما انفك هذا الرمز – في الوعي الجمعي – ميثاقًا بين الوطن وأبنائه، ورايةً تُرفَع لا لترفٍ ولا زينة، بل للهيبة، والانتماء، والكرامة.
ثالثًا: أركان جريمة إهانة العلم
لما كان العَلمُ هو اللسان الصامت للوطن، والراية التي تتكثّف فيها رمزية الدولة وسيادتها، فإن المساس به لا يُعدّ طعنًا في قطعة قماشٍ ترفرف، بل هو – في حقيقته – طعنٌ في القلب النابض للهوية، وتحدٍّ فجٌّ لهيبة الدولة وهي مرآةٌ لأبنائها. ومن ثَم، فقد صاغ المشرِّع جريمة إهانة العلم المصري على ثلاثة أركان رئيسة، كلُّ ركن منها كأنّه عمودٌ في بناء التجريم، لا يستقيم الحكم إلا باجتماعها.
1- الركن المادي:
ولا ريب أن جوهر الجريمة يتمثل أولًا في فعلٍ ماديٍّ ظاهرٍ للعيان، يأتيه الجاني عمدًا، يكون من شأنه أن ينال من كرامة العلم أو يُنقص من هيبته ومكانته في وجدان الناس. ولئن كانت الأفعال تتعدّد، فإن الجامع بينها هو دلالتها على الاحتقار أو الاستهانة، سواء أكان الفعل تمزيقًا متعمّدًا، أو حرقًا بغيضًا، أو دوسًا بالأقدام في مشهدٍ يُراد به الإذلال، أو طرحًا له في القمامة كأنّه نفاية، أو عرضًا له في صورةٍ تهكمية تسخر من رمزيته وتُهوِّن من شأنه.
ولا تقوم الجريمة على هذه الأفعال في الخفاء، بل يُشترط أن يكون الفعل مشهودًا، أو مُعلَنًا، سواء في ساحةٍ عامة، أو عبر الوسائط الحديثة التي لا يعزب عنها بصرٌ في هذا العصر الرقمي؛ كالنشر على منصات التواصل، أو العرض عبر الشاشات، أو التوزيع في منشوراتٍ جماهيرية. إذ العلانية في هذا السياق ليست شرطًا شكليًا، بل هي روح الجريمة، لأنها تُشيع الإهانة وتحوّل الفعل الفردي إلى صدى جماعي، فيه استفزازٌ للضمير العام، وجُرحٌ لكبرياء الدولة.
2- الركن المعنوي:
وأما الركن الثاني، فهو القصد الجنائي الذي يُشكّل القلب الحقيقي للجريمة، إذ لا يكفي أن يقع الفعل، بل لا بدّ أن يكون الفاعل عالمًا بطبيعته، مريدًا لإحداث أثره المهين. فالجريمة عمدية لا لبس في طبيعتها، ولا تقوم على زلّة عابرة أو سهوٍ مغفور، بل تُقام حيث يكون الفاعل قد تعمّد الفعل، وأراد من ورائه تحقير العلم، أو الانتقاص من رمزيته، أو إثارة البلبلة من خلال إهانة رمزٍ تُجِلّه الدولة وتُقدِّسه في الوعي الجمعي.
فلو كانت اليد التي امتدّت إليه جاهلةً بحرمته، أو خلطت بينه وبين غيره، أو أقدمت على الفعل بلا نيةٍ مهينة، فلا قيام للجريمة. ذلك أن القانون لا يُعاقب على مجرد الفعل، بل على الفعل المصحوب بنيةٍ خبيثة، وغايةٍ مستترة تنكشف من خلال الملابسات والدلالات.
ولا غرو، فالعلم ليس مجرّد شارة تُهمل، بل هو، في عيون الدول، كتاجٍ على الجبين، إن سقطَ، سقطت معه المهابة، وإن أُهين، اهتزّت معه أركان الاحترام الوطني في النفوس.
رابعًا: عقوبة جريمة إهانة العلم
لما كان العَلمُ شارةَ السيادة، ومهوى الأفئدة في مواكب الوطنية، ولما كان الاعتداء عليه لا يُعدّ جُرمًا شخصيًا فحسب، بل يُعَد – في جوهره – فعلًا يهزُّ كيان الدولة ويُهين رمزها الأعلى، فقد نهض المشرّع المصري، مُتيقّظًا لخطورة هذا المساس، إلى تقرير عقوبة جنائية صريحة، تصون لهذا الرمز قدسيته، وتضرب على يد كل من تسوِّل له نفسه أن يعبث بأعمدة الهوية ومرايا الانتماء.
وقد نصّ القانون صراحة على أن عقوبة هذه الجريمة هي الحبسُ مدةً لا تزيد على سنة، أو الغرامةُ التي لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإن عاد الجاني إلى فعلته بعد صدور حكمٍ باتٍ في الواقعة الأولى، تضاعفت العقوبة، إذ العَوْدُ في هذا المقام ليس إلا إمعانًا في التحدي، وتكرارًا للفعل مع سبق الإصرار والاستخفاف بهيبة الدولة، ولا جرم أن المشرّع لم يغفل عن هذا التمادي، فشدّد العقوبة لتكون زجرًا ورادعًا مضاعفًا.
ولا غرو، فالقانون في مواضع السيادة لا يرحمُ من استباح المقدَّس، ولا يُهمله لضميرٍ قد يهون عليه الوطن. غير أن المشرّع، بما عُرف عنه من حكمةٍ وتقدير لمقامات الفعل والفاعل، لم يُنزل العقوبة على نحوٍ جامدٍ لا يراعي الفوارق الدقيقة بين الملابسات، بل ترك للقاضي الجنائي سُلطةً تقديرية واسعة، يستخلص بها من السياق ما يُفهم به القصد، ويُحدّد على ضوئه ما إذا كان الفعل يستحق الحبس أو الغرامة، وهل يستوجب الشدة أم تَسمُح له الرحمة بمساحةٍ من التخفيف.
أتراهُ، إذ يوازن بين النصوص والوقائع، كأنما يُمسك ميزانًا دقيقًا من نورٍ وحديد، يُقدّر به مقدار الجُرم، ويَزن به ما يستحقه من العقاب.
وما انفكَّ القانونُ – في جرائم الرمزية والسيادة – يُعلي من قيمة الكرامة الوطنية، ويُغرس في رُوَاة العدالة أن العلم ليس ملكًا لحكومة، بل هو عقدٌ مقدّس بين الدولة وشعبها، وأن الإهانة التي تصيبه، إن لم تُواجَه بالحزم، تفتح الباب لموجاتٍ من التمرد الصامت، والهوان المستتر.
الخاتمة :
ختامًا، فإن العَلَمَ ليس مجردَ قُماشةٍ تخفقُ في السماء، بل هو كالسيفِ في غِمدِه، والدرعِ في ميدانِ الكرامة، والنبراسِ الذي يُهتدى به في دياجيرِ التاريخ. هو وشمُ العزة على جبينِ الوطن، وهو الرمزُ الذي تنحني له الهامات لا ذلًّا، بل إجلالًا لصوت الأرض وهي تنادي أبناءها بلسان المجد.
وقد بيّنا في هذا المقام معنى العَلَم لغًة واصطلاحًا، ووقفنا عند أركان جريمة إهانته، وعقوبتها، وما اعترى النص التشريعي من قصورٍ يستدعي مراجعة وتدعيمًا، فالعقوبة في صورتها الحالية لا تفي بقداسة الرمز ولا تحقّق الردعَ المنشود. واقترحنا تشديد النصوص، وتوسيع دائرة الظروف المشددة، وفرض العقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية، ليبقى العَلَمُ مصونًا كما تصان الدماء، محفوظًا كما تُحفَظُ الذمم.
فيا من تُسوِّل لك نفسك أن تعبث براية الوطن، اعلم أنك لا تمزق قماشًا، بل تَسحق تاريخًا، وتُهدِر هيبة، وتطعن في قلب وطنٍ صاغته التضحيات ونسجته دماء الشهداء. فالعَلَمُ ليس مجرد رمز، بل هو وجه مصر، وصوتُها حين تصمتُ الأصوات، وهويةٌ حين تتنكر الهُويات، وعهدٌ لا يُنقَض، وأمانة لا تُخَان.
عند النظر في العقوبة التي فرضها المشرّع المصري على جريمة إهانة العلم المصري، نجد أن النص قد جاء في صورته الأولية معتمدًا على الموازنة بين الحبس والغرامة في نطاقٍ ضيقٍ نسبًا، حيث لا تزيد العقوبة في صورتها البسيطة على سنة واحدة من الحبس، أو غرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه. وعلى الرغم من أن المشرّع قد ترك للقاضي سلطة تقديرية في تطبيق العقوبة، إلا أننا نرى أن هذا التقدير ينبغي أن يكون مشروطًا بالوضع العام، بما يتماشى مع طبيعة الجريمة التي يمسّ فيها الجاني رمز سيادة الدولة وكرامتها.
ومما لا شك فيه أن الفعل الإجرامي الذي يستهدف العلم ليس كالاعتداءات البسيطة التي تقتصر على الأضرار الفردية أو الاعتداءات المادية التي تمس الأشخاص. فالإهانة التي يتعرض لها العلم المصري هي في حقيقتها طعنٌ في هيبة الدولة، وتعدٍ على رمزٍ حيٍّ من رموز السيادة، ولهذا لا ينبغي أن تكون العقوبة في إطارها البسيط مجرد حبسٍ لمدة سنة أو غرامةٍ مالية.
إن الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة معًا في مثل هذه الجرائم من شأنه أن يُحَقِّق الردع المطلوب ويُرسِّخ قدسية العلم في الذاكرة الجمعية للمواطنين. فالحبس – لجوهره القيمي – يعبّر عن تأديب الجاني وحرمانه من حريته، بينما الغرامة تعمل على رد الاعتبار المادي والمعنوي، وتجبر الضرر الذي يسببه الفعل في النفوس. ومن هنا، كان يجب أن يشمل النص التشريعي عقوبة مزدوجة، لا تكتفي بإحدى العقوبتين، بما يتماشى مع فداحة الفعل الذي يُقدِّم عليه الجاني.
ثم يأتي ما يجب أن يُنتقد بقوة: ألا وهو أن المشرّع قد جعل “العود” وحده ظرفًا مشددًا للعقوبة. هذا النقص الكبير في النصوص التشريعية يُعدُّ تناقضًا مع طبيعة الجريمة، فإذا كان التكرار يستوجب التشديد، فما بالنا بأولئك الذين يطوّعون العلم لغاياتهم الشخصية، أو يُقدِّمون على انتهاك قدسية الرمز في محافل عالمية أو أمام جمهور عريض؟ فلا جرم أن العبث بالعلم في دولٍ أجنبية يُعدُّ في ذاته تصرفًا يُشكِّل أسمى درجات الاستهانة بكرامة الدولة، بل هو تحدٍّ صريح لما تمثله الدولة من هيبة في الخارج. في مثل هذا الوضع، يتحول الفعل إلى ما يُشبه العصف بكل المعاني الوطنية، حيث تُشهر الدولة سيف الاعتداء على أحد أهم رموزها أمام الأنظار العالمية، مما يؤدي إلى تشويه صورتها في أذهان الشعوب الأخرى، ويشبع قلوبهم بشبهة الاستهتار بسيادتها.
إن ذلك يجعلنا نرى أن العبث بالعلم في الخارج يجب أن يُعتبر ظرفًا مشددًا للعقوبة، بل أن يشمل العقوبة أشد درجات التشديد إذا وقع في سياق المحافل الدولية، وفي ضوء حضور حشود من جمهورٍ عالمي، يُشهَد فيه على ذلك التصرف المهين. فلا غرو أن هذا الفعل يُعبِّر عن استخفاف لا يقل عن قذف الدولة في هيبتها، ويؤثر سلبًا على موقفها الدولي. فكيف لا يُحسن المشرّع التعامل مع هذه الحالات التي تمس مكانة الدولة في الخارج؟
أيضًا، ما كان يتراءى لنا أنه كان من الأولى – في سياق قانون يهدف إلى الحفاظ على الرموز السيادية – أن يتضمن النص تشديد العقوبة في حالة أن تقع الجريمة في محفلٍ يشهده جمعٌ من الناس، سواء كان محفلًا رياضيًا، أو تجمعًا سياسيًا، أو احتشادًا شعبيًا. ففي تلك الحالة، يكون الفعل أبلغ في دلالته، ويظهر الأثر السلبي له في التشكيك في سلطة الدولة ورمزها أمام أعداد غفيرة من الأفراد، ما يزيد من درجة إهانة العلم وتدنيسه أمام العيون المتطلعة.
في ضوء ذلك، نرى أن التشريع المصري في مجاله الخاص بجريمة إهانة العلم قد فاتته بعض الاعتبارات الجوهرية التي كان يجب أن ترفع العقوبة إلى مستوى الردع العام، وهو ما يقتضي ضرورة إعادة النظر في النصوص وتوسيع دائرة التشديد في حالات معينة، على نحوٍ يتماشى مع الخطورة السياسية والاجتماعية لهذه الجريمة، ويُحسن من فاعلية الردع.
ظروف أخرى تستدعي تشديد العقوبة في جريمة إهانة العلم
-
الظرف المتعلق بنقل الفعل عبر وسائل الإعلام:
إن نقل جريمة إهانة العلم عبر وسائل الإعلام، سواء كانت وسائل تقليدية كالصحافة والتلفزيون، أو عبر الوسائل الحديثة مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يُعدُّ ظرفًا مشددًا للعقوبة. فحين يُنقل هذا الفعل المشين إلى جمهور واسع، تتسع دائرة الأثر السلبي لهذه الجريمة، ويتسرب الانتهاك إلى عقول الأفراد في مختلف الأوساط الاجتماعية.
فالتمادي في نشر هذا الفعل عبر وسائل الإعلام يضاعف من تهديد هيبة الدولة أمام العالم، ويجعل هذا الانتهاك طعنًا مباشرًا في كرامتها أمام الأعين المتطلعة. وعليه، فإن هذا الانتشار الواسع للفعل يُعدُّ استهانة غير مقبولة برمزية العلم، ويجب أن يُعتبر ظرفًا مشددًا للعقوبة، بما يعكس خطورة تأثيره على الرأي العام المحلي والدولي. -
الظرف المتعلق بالشخص الذي يمثل مصر في منصب عام أو يتقلد وظيفة في الدولة:
إن ارتكاب جريمة إهانة العلم من قبل شخص يتقلد منصبًا عامًا أو يشغل وظيفة حكومية يُعدُّ ظرفًا مشددًا يستوجب مضاعفة العقوبة. فالشخص الذي يمثل الدولة في منصب رسمي يحمل على عاتقه أمانة تمثيل الدولة أمام مواطنيها وأمام العالم. وبالتالي، فإن أي تصرف منه يمس رمزية العلم يعد أكثر جسامة، ويشمل في طياته رسالة سلبية قد تُسهم في تقويض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
فإذا كان الشخص الذي ارتكب الجريمة ينتمي إلى صفوف المسؤولين الحكوميين أو السياسيين، فإن ارتكاب هذه الجريمة يُعتبر انتهاكًا مضاعفًا للثقة العامة في النظام الحاكم، ويجب أن يعاقب بشكل أشد بما يتماشى مع خطورة الفعل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. -
الظرف المتعلق بتكرار الفعل في أماكن حساسة:
إذا ارتُكبت جريمة إهانة العلم في مكان حساس أو مؤسسة ذات صلة بالدولة، كالمؤسسات الحكومية، المكاتب الدبلوماسية، أو المواقع العسكرية، يجب أن يُعتبر ذلك ظرفًا مشددًا. فالفعل في هذه المواقع يتسق مع محاولات العبث بمؤسسات الدولة ذات القدسية، ويُعزز من تأثير الجريمة في تهديد النظام العام وتهز صورة الدولة في الداخل والخارج.
إن هذه الظروف مجتمعة من شأنها أن تعكس خطورة الفعل بشكل أكبر، وتستدعي من المشرع المصري إعادة النظر في النصوص القانونية بحيث تشمل تشديد العقوبة بشكل يتناسب مع فداحة الجريمة وتأثيراتها الاجتماعية والسياسية.
التوصيات :
وإيذاءَ ما تقدَّم، ودرءًا لما قد ينال من رمزية العَلَم المصري ومكانته، نوصي بمشروع قانونٍ يُصاغ على النحو الآتي:
“يعاقب كل من أهان العلم المصري بأي طريقة من شأنها أن تحط من قدره بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى وفي حالة العود، أو إذا كانت الإهانة في محفل عام يشهده جمع غفير أو في حالة ارتكاب الفعل في دولة أجنبية.
كما يجوز للمحكمة فرض عقوبات تكملية أو تدابير احترازية، مثل:
- منع المحكوم عليه من السفر إلى الخارج لمدة لا تقل عن سنة.
- إلزام المحكوم عليه بتقديم اعتذار علني في وسائل الإعلام المصرية.
- إلزام المحكوم عليه بالمشاركة في برامج توعية ثقافية وقانونية حول أهمية احترام الرموز الوطنية.
- سحب أي تصاريح أو تراخيص مرتبطة بالمحكوم عليه إذا كان يشغل منصبًا عامًا أو له علاقة مباشرة بمؤسسات الدولة.
توصيات شكلية:
- دور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية: يجب على الأزهر الشريف والكنيسة المصرية أن يتبنيا دورًا رئيسيًا في نشر الوعي بأهمية العلم المصري وقدره. من خلال خطب ودروس دينية تُركّز على قيمة العلم كرمز للوحدة الوطنية والهوية المصرية، بما يرسخ في نفوس الأفراد احترام العلم كرمز للسيادة الوطنية. كما يمكن عقد ندوات ثقافية ودينية تُعزز احترام هذا الرمز في المجتمع.
- دور المدارس والجامعات: على المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات أن تضمِّن برامج تعليمية في المناهج الدراسية تركز على تاريخ العلم المصري ومكانته كرمز للسيادة الوطنية. كما يمكن تنظيم فعاليات مدرسية وجامعية لرفع العلم بشكل رسمي، بالإضافة إلى إجراء مسابقات ثقافية وفنية حول العلم وأهميته في الهوية الوطنية. يجب أن يتعلم الطلاب في جميع المراحل العمرية أن العلم ليس مجرد قطعة قماش، بل هو رمز لمستقبل الوطن وعزته.
- دور الأسرة والمجتمع: تلعب الأسرة دورًا محوريًا في غرس احترام العلم المصري في نفوس الأطفال منذ الصغر. يجب على الأهل أن يعلموا أطفالهم أهمية العلم وكيفية التعامل معه بوقار واحترام. كما يمكن للمجتمع المدني أن ينظم حملات توعية في الأحياء والمناطق السكنية لتعريف المواطنين بمكانة العلم المصري. ينبغي أن يُشرك الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب في نشر هذه الثقافة عبر برامج توعية حوارية، ومقالات، وبرامج شبابية تساهم في التأكيد على أن إهانة العلم هي إهانة للدولة بأكملها.
- دور الإعلام في التوعية: يجب على وسائل الإعلام المختلفة أن تقوم بدورها في تعزيز ثقافة احترام العلم المصري، سواء من خلال برامج تعليمية أو إعلانات توعوية أو تغطية إعلامية لفعاليات تحترم العلم وتبرز قيمته. إن إعلامًا من هذا النوع يعزز من قيم الانتماء والولاء، ويُسهم في جعل العلم في الوعي الجمعي جزءًا من هوية المجتمع المصري.
“لِمَن تسول له نفسه المساس بعِزَّة العلم المصري، لا تَغِبْ عن عينيك شموخ هذا الرمز، الذي هو أبعد من مجرد قماش، هو سارية وطننا الحبيب، وصوت السيادة في الأفق، هو حكاية التاريخ، وأمل المستقبل، ومجد الأجداد. فلا تظن أن يهنأ لك عيش وأنت تطعن في عزة مصر، فالوطن لا يهان، ورموزه لا تُدَنَّس، ومن يسعى للمساس بها، فقد مسَّ كرامة كل مصري ومصريّة، وستظل مصر بأعلامها خفاقة، قوية، شامخة لا تهتز أمام ريح الطغيان.”