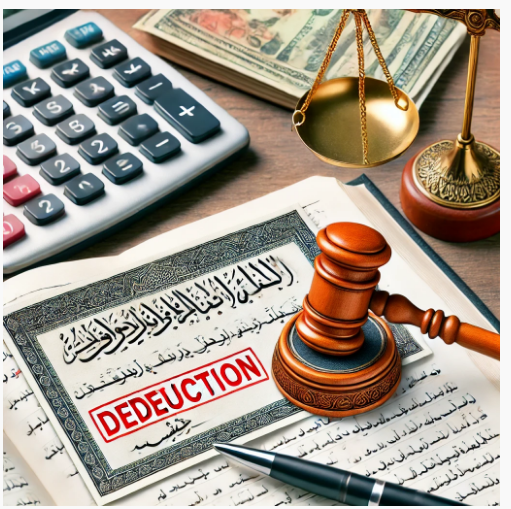مقدمة:
لا غرو أن مبدأ الخصم من المرتب أو اقتطاع جزء من المال نتيجة التقصير ليس محض إجراء إداري مستحدث، بل هو أصلٌ راسخ في التشريع الإلهي، إذ ارتبطت المسؤولية المالية في الشريعة الإسلامية بقواعد العدل والموازنة بين الحقوق والواجبات، بحيث لا يكون الجزاء إلا بقدر العمل، ولا يُنقص من الأجر إلا بقدر التقصير. ولقد قرر القرآن الكريم هذا المبدأ في مواضع عدة، فجعل الاقتطاع المالي صورة من صور العقوبة العادلة، كما في قوله تعالى في شأن أصحاب الجنة: “فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ” (القلم: 19-20)، حيث نُزعت منهم الثمار عقابًا على نيتهم حرمان الفقراء.
وفي سياق المعاملات المالية، أرسى القرآن الكريم قاعدة ربط الجزاء بالعمل، فقال تعالى: “وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ”(النجم: 39)، تأكيدًا على أن الأجر حق مكتسب لمن أدى عمله بإتقان، بينما يكون الخصم مشروعًا عند الإخلال بالواجبات. بل إن التشريع الإلهي جعل التخفيض أو الاقتطاع المالي قاعدة في العقود، كما في قوله تعالى: “فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ” (البقرة: 237)، حيث تقرر تخفيض المهر إلى النصف عند الطلاق قبل الدخول، مما يدل على أن الخصم المالي جزء من النظام العادل الذي يحكم الالتزامات.
وبذلك، يتضح أن هذا المبدأ ليس وليد الأنظمة الحديثة، بل هو قاعدة تشريعية قرآنية تهدف إلى تحقيق العدل، وضبط الحقوق المالية، بحيث لا يُحرم عامل من أجره، ولا يُجازى مقصّر بأجر لم يستحقه، مما يجعل هذا المبدأ أحد أهم تجليات الميزان الإلهي في المعاملات.
١- الخصم بسبب التقصير في الأمانة: قصة أصحاب الجنة
ولما كان العدل ميزان الوجود، والحقوق لا تستقيم إلا بتوازنها بين الالتزام والجزاء، فقد أرست الشريعة الإلهية مبدأً راسخًا يقضي بارتباط العمل بمقتضيات الثواب والعقاب، بحيث لا يكون للإنسان إلا ما سعى، ولا يؤتى من الأجر إلا ما استحقه بجهده وإتقانه. وإذ كان النظام الإداري الحديث قد أقرّ مبدأ الخصم من المرتب أو اقتطاع جزءٍ من المال عند التقصير أو المخالفة، فإن هذا المفهوم ليس بدعًا من التشريعات المستحدثة، بل هو استلهام دقيق لمنهج إلهي محكم، حيث قرر القرآن الكريم أن من فرّط في الأمانة أو قصر في الواجب، فإن عدالة السماء تقتضي أن ينال جزاءً من جنس عمله، إذ كيف يستوي من أدى حق العمل ومن أخلّ به؟
وفي هذا السياق، يأتي المثال القرآني البديع في قصة أصحاب الجنة، حيث جازاهم الله عز وجل بحرمانهم مما راموا حرمان الفقراء منه، فقال تعالى: “إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ” (القلم: 17-20). فكان سعيهم جهدًا ضائعًا، وسلط الله على أموالهم ما أفناها، كزرع استحكمت فيه النار حتى لم تُبق منه شيئًا، فكان هذا الخصم الإلهي عقوبة عادلة لما اقترفوه من بغيٍ وجور.
ولئن كان هذا المبدأ واضحًا في العقوبات الإلهية، فإنه ماثل كذلك في المعاملات المالية التي شرّعتها الشريعة الغرّاء، حيث أقرّ القرآن الكريم تقليص المستحقات المالية في حال الإخلال ببنود العقد، كما في قوله تعالى: “فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ”(البقرة: 237)، إذ جعل الشرع الحكيم نقصان الأجر عند انتفاء الاستحقاق، تأكيدًا على أن الالتزام لا يثبت إلا ببذل الجهد واستيفاء الشروط. وهذا عين العدل الذي لا يعرف محاباةً، ولا يغفل عن تفصيل الحقوق.
وفي ميدان الإثبات المالي، أوجب القرآن الكريم التوثيق حفظًا للحقوق وصونًا للأمانات، فقال جل شأنه: “يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ” (البقرة: 282). فكان التدوين أداة لضبط التعاملات ومنع التلاعب، حتى لا يدّعي مُدَّعٍ ما ليس له، أو يُحرم صاحب حق مما هو له، وإلا اختلّ ميزان العدل، وأضحى المال في أيدي العابثين كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يملك صاحبه منه نفعًا ولا يأوي منه إلى مستقر.
ولم يكن هذا المنهج مقتصرًا على الديون والحقوق الفردية، بل امتدّ إلى تنظيم الشراكة بين الأطراف، إذ جعل القرآن الكريم العدل والتوازن أساسًا للتعامل بين الشركاء، فقال تعالى: “وَإِن كَثِيرًا مِّنَ ٱلشُّرَكَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ” (ص: 24)، فبيّن أن طبيعة الشراكة قد تكون بابًا للظلم ما لم يُحكمها العدل، وما انفكّت الشريعة عن تقرير أن كل انحراف عن الإنصاف يستوجب العقوبة، إما في الدنيا بنقصان المال وزوال البركة، وإما في الآخرة بعقاب لا مردّ له.
إذ ذاك، يتضح أن الاقتطاع من المرتب أو الخصم من المال عند التقصير ليس إلا امتدادًا لمبدأ إلهي أصيل، أرسته الشريعة لتقرير العدالة المالية، وضبط الحقوق بين العباد، حتى لا يكون المال دولةً بين فئة دون أخرى، أو سبيلًا لاستباحة الجهد بلا مقابل. أفلا يتدبر العاقل هذه السنن المحكمة، فيوقن أن كل فلسٍ يُقتطع نتيجة تقصير، ما هو إلا تنزيل دنيوي لقانون سماوي عادل، لا يحابي أحدًا، ولا يخطئ الميزان؟
٢- الخصم من الأجر بسبب عدم الوفاء بالعهد
ولما كان العدل أساس الملك، وكان ميزان الحقوق لا يستقيم إلا بضبط العلاقة بين الجهد والجزاء، جاءت التشريعات الإلهية لتؤكد أن من قصّر في أداء الأمانة، أو فرّط في واجبه، استوجب نقصانًا في استحقاقه، فلا غرو أن يكون مبدأ الخصم المالي، سواء في صورته الحديثة كاقتطاع من المرتب، أو في سياقه الأوسع كمبدأ مالي وقانوني، متأصلًا في النظام الرباني الذي لا يحابي أحدًا، ولا يميل مع الهوى.
ففي القرآن الكريم، يُربط الجزاء بالأعمال، ومن لم يفِ بعهده أو أخلّ بمسؤولياته، فإنه يتعرض لنقصان ما يستحقه، كما في قوله تعالى: “أَوَفُوا۟ بِٱلْكَيْلِ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ” (الشعراء: 181). فكانت العدالة المالية تقتضي أن يُعطى كل ذي حقٍّ حقه بتمامه، فإن تلاعب أو قصر، فليس له أن يطلب ما لا يستحق، بل يكون النقصان جزاءً وفاقًا، كما قال تعالى: “وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ” (المطففين: 1-3).
وهذا ليس إلا صورة من صور العدل الإلهي، الذي قضى بأن يَلقى الإنسان من الجزاء ما يناسب فعله، ومن قَصُر عن الوفاء بالتزامه، فإنما يجني على نفسه نقصانًا في العطاء، كالموظف الذي يخلّ بواجباته، فلا يكون له أن يطالب بالأجر كاملًا، إذ كيف يستوي المجدّ والمفرّط في ميزان الحق؟
بل إن هذا المبدأ يتجلى بوضوح في قصة أصحاب الجنة الذين أرادوا أن يمنعوا الفقراء من نصيبهم، فحُرموا هم أنفسهم من المال كله، فقال تعالى: “إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ” (القلم: 17-20). فما هو إلا قانون سماوي نافذ، إذ إن من ضيّق على غيره ضُيّق عليه، ومن بَخِل حُرم، ومن خان الأمانة فَقَد رزقه، فكان اقتطاع نصيبهم عقوبة عادلة لظلمهم.
وهذا المنهج لم يقف عند حدّ العقوبات الإلهية العامة، بل امتد ليشمل أدق تفاصيل المعاملات المالية، إذ أقرّ القرآن الكريم نقصان المستحقات المالية عند الإخلال بالشروط، فقال تعالى: “فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ” (البقرة: 237)، فكان العدل يقتضي أن يُدفع الأجر بمقدار الالتزام، فإن وقع الإخلال، لم يكن من العدل دفع الأجر كاملًا، بل يتناسب الجزاء مع العمل المنجز، وإلا كان الحكم ضربًا من المجازفة، كمن يمنح الميزان المختل حكم الميزان العادل.
ثم إن مبدأ الإثبات في الشريعة جاء مؤكدًا على ضرورة ضبط التعاملات المالية حتى لا يُظلم أحد، فقال تعالى: “يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ” (البقرة: 282)، فكان التوثيق أداة لحفظ الحقوق، وصيانةً من أي تلاعب قد يؤدي إلى إنكار المستحق أو إنقاص أجر العامل بلا وجه حق. إذ ذاك، يتبين أن الخصم أو الاقتطاع المالي لا يعدو أن يكون صورةً حديثةً لنظام دقيق أرسته الشريعة، وجعلته أساسًا لحفظ الحقوق، حتى لا يكون المال في يد المقصّر كظلٍّ ممدود سرعان ما يتلاشى حين يقترب منه.
وفي مجال الشراكة، جاء القرآن ليحذّر من الظلم المالي بين المتشاركين، فقال تعالى: “وَإِن كَثِيرًا مِّنَ ٱلشُّرَكَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ” (ص: 24)، فبيّن أن العلاقة المالية بين الشركاء قد تتحول إلى ميدان للظلم والطغيان، ما لم يكن العدل حاكمًا لها، وما لم يُضبط الجزاء وفقًا لما يستحقه كل طرف، وإلا صار المال سلاحًا في يد المتلاعبين، يأخذون أكثر مما يستحقون، أو يمنعون الآخرين حقوقهم.
إذ ذاك، فإن مبدأ الخصم المالي، سواء في صورة اقتطاع من المرتب أو نقصان في المستحقات، ليس إلا انعكاسًا لمنهج إلهي دقيق، يقوم على أن الأجر يتبع العمل، والجزاء مرتبط بالسعي، فمن بذل جهده أخذ حقه، ومن قصّر وجب عليه أن يتحمل تبعات تقصيره، فإنما الأمر كما قال تعالى: “وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ” (النجم: 39).
٣- الخصم كعقوبة تأديبية: قصة بني إسرائيل
ولما كان العدل ميزان الله في الأرض، فلا غرو أن يُنزِل العقوبات الإلهية على من أعرض عن أوامره وجحد نِعَمه، إذ كيف تستقيم موازين الحق إذا لم يرتبط الجزاء بالعمل، والثواب بالطاعة، والعقاب بالجحود والتقصير؟ ولقد ضرب الله تعالى مثلًا بالغًا في بني إسرائيل، الذين لم يزدهم الكفر بالنعم إلا بطرًا، فجاء العقاب الإلهي ليحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم، إذ سُلبت عنهم العزة، وضُربت عليهم الذلة والمسكنة، وجُعلوا تحت وطأة الغضب الرباني، كما قال تعالى:
“وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوا۟ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بَِٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّۦنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ” (البقرة: 61).
فهذه العقوبة لم تكن مجرّد أثرٍ أخروي، بل طالت معاشهم، وألقت بظلالها على أرزاقهم، فكان الحرمان نصيبهم، والفقدان مآلهم، وذلك جزاء وفاقًا لما قدمت أيديهم. وإذ ذاك تتجلى سنة الله في خلقه: من خان العهد، وضيّع الأمانة، واستحلّ الحقوق، كان كمن هدم بنيانًا متينًا بيديه، فلا يجد إلا أطلالًا خاويةً، يندب فوقها سوء المصير.
٤- الخصم بسبب عدم الامتثال للأوامر: قصة طالوت والجنود
ولما كانت الطاعة والالتزام ركنًا في بناء أي نظام متماسك، فقد سنّ الله سننًا عادلة تُرتّب الجزاء على قدر الامتثال أو المخالفة، إذ إن من خرج عن الأوامر وتمرّد على الضوابط، كان لزامًا أن يُحرم من الامتيازات التي كان يتمتع بها. ومن أبلغ ما جسّد هذا المبدأ ما ورد في ابتلاء الله لجنود طالوت بالنهر، حين أمرهم بألا يشربوا منه إلا مقدار غرفة باليد، فجعل الامتحان معيارًا دقيقًا للانضباط، فمن تجاوز الحد واستباح الشراب بغير قيد، نُزعت منه أهلية المشاركة، وخسر امتيازه كجندي في جيش الحق، قال تعالى:
“إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۭ بِيَدِهِۦ” (البقرة: 249).
وهذا النص القرآني يرسي قاعدة في غاية الأهمية، مفادها أن الإخلال بالقواعد يُوجب الحرمان من الحقوق والامتيازات، وأن العقوبة لا تقتصر على الجزاء الأخروي، بل تمتد إلى الواقع فتُطبّق على المخالفين بسلب ما كانوا يستحقونه لو أنهم التزموا بالأوامر. فكأن هؤلاء الجنود الذين تجاوزوا الحد، قد فُرض عليهم “خصم وظيفي”، إذ حُرموا من شرف القتال تحت راية العدل، وانسلخوا عن الصف الذي اصطفاه الله للنصر، فكان إخلالهم بالقواعد سببًا في إقصائهم، كما يكون الإخلال بالمسؤوليات سببًا في فقدان الامتيازات، سواء في النظم الدنيوية أو في موازين العدالة الإلهية.
الخاتمة: مبدأ الخصم في القرآن بين العقوبة والتأديب
ولما كانت العدالة ركنًا ركينًا في بناء المجتمعات، وميزانًا تستقيم به الحقوق والواجبات، كان من مقتضياتها أن يُقرن العمل بالجزاء، وأن يكون الاستحقاق مرهونًا بالوفاء بالالتزامات. فالخصم من الأجر، وإن بدا في صورته الإدارية الحديثة إجراءً تنظيميًا، فإنه في حقيقته أصلٌ أصيلٌ من أصول الميزان الإلهي الذي أقام الله به العدل، إذ جعل لكل عمل جزاءً يناسبه، فمن وفّى استُوفي له حقه، ومن قصّر استوجب النقصان، ومن خان الأمانة لم يكن له أن يطمع في أجرٍ لم يستحقه.
وهذا المبدأ، الذي يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، تجلّى في صور شتى في القرآن الكريم، حيث ربط الله سبحانه بين الأداء والمكافأة، وبين التقصير والعقوبة، فجعل الجزاء من جنس العمل، كما في قوله تعالى: “وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلأَوْفَىٰ” (النجم: 39-41)، فدلّت هذه الآية على أن كل امرئٍ مرهونٌ بعمله، لا يُعطى فوق ما اجتهد فيه، ولا يُمنح ما لم يسعَ إليه، بل يُجازى بقدر ما قدّم، فإن أتمّ عمله دون نقصان، كان له أجره موفورًا، وإن أخلّ أو قصّر، كان النقصان حتمًا جزاءً له.
ولعل من أعظم الصور التي تعكس هذا الميزان الإلهي في مسألة الاقتطاع، ما أورده القرآن الكريم في شأن أصحاب الجنة الذين قصدوا أن يمنعوا الفقراء من حقهم المشروع في الزرع، فكان العقاب الإلهي أن حُرموا هم أنفسهم من النعمة كلها، قال تعالى: “إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ” (القلم: 17-20). وفي ذلك إشارةٌ بليغةٌ إلى أن من جحد الحقوق أو أراد الاستئثار بما ليس له، فقد يُحرم مما بين يديه، ويُقتطع منه كما قصد أن يقتطع من غيره، وهذه سنةٌ إلهيةٌ لا تتخلف.
ولم يقف القرآن الكريم عند هذا الحدّ، بل ضرب مثالًا آخر على أن من يتجاوز الحدود أو يخالف القوانين، فإنه قد يُستبعد من موضعه، كما في قصة جنود طالوت، حينما اختبرهم الله بنهرٍ، فمن شرب منه بغير إذن حُرم من المشاركة في القتال، قال تعالى: “إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۭ بِيَدِهِۦ”(البقرة: 249). فكان ذلك خصمًا من حق المشاركة العسكرية، وجزاءً لمن لم يلتزم بالأمر، وهي قاعدةٌ تتسق مع مبدأ الاقتطاع من الأجر لمن لم يفِ بعمله.
وما انفك القرآن الكريم يعكس هذا المنهج العادل، إذ أكّد أن الميزان لا يُقيمه إلا القسط، كما في قوله تعالى: “وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ” (الرحمن: 9)، وهذا يشمل كل موازين التعاملات المالية والوظيفية والحقوقية، بحيث يكون كل اقتطاعٍ مستندًا إلى ميزانٍ دقيقٍ من العدل، فلا يُخصم إلا بحق، ولا يُستقطع إلا ببرهان، وإلا كان ذلك جورًا لا عدلًا.
وختامًا، فإن مبدأ الخصم من الأجر أو المرتب ليس مجرد إجراءٍ إداريٍّ حديثٍ، بل هو سنةٌ كونيةٌ وقاعدةٌ شرعيةٌ ترسّخت في القرآن الكريم، بحيث يُعامل كل امرئٍ بقدر ما قدّم، فإن كان حسن الأداء، استحقّ الجزاء، وإن قصّر، لزمه النقصان، وذلك هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، كما قال تعالى: “وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ”(الأنعام: 115).