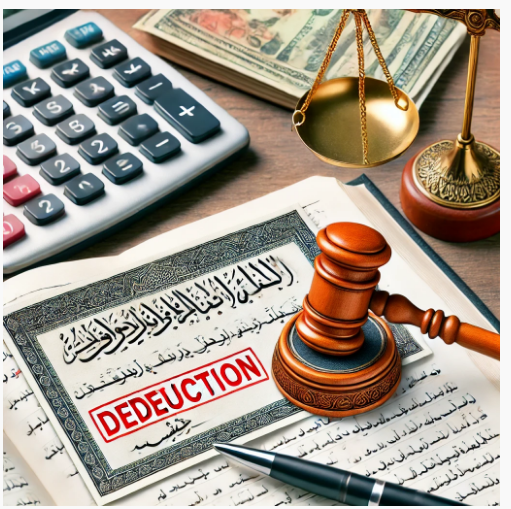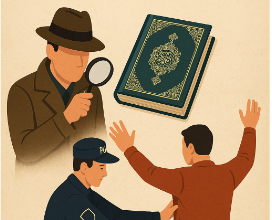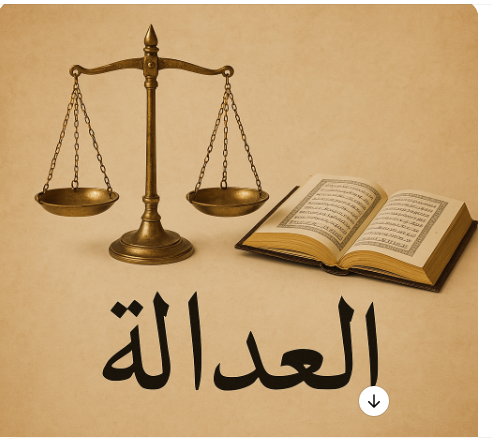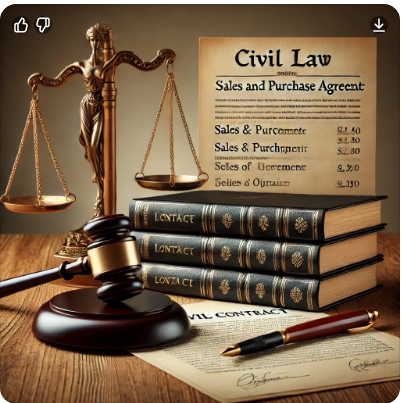مقدمة
في مشهدٍ يشوبه الخذلان الإنساني وتكتنفه غيوم الجحود، يُطلّ علينا الامتناع عن تسليم الميراث كفعلٍ لا يقلُّ في فظاعته عن خيانةٍ موصوفةٍ، جُبلت على الغدر، وتزيّت برداء القربى، وانسلّت من بين أهداب الرحم كالأفعى التي تخرج من جحر الأمومة، لا لتُعانق، بل لتلدغ. فأتراه جُرمًا عارضًا؟ أم هو طبعٌ مسمومٌ غائرٌ في تلافيف النفس، تشرّبته الأرواح العليلة كما يتشرّب الرملُ الحارُّ الدم النازف فلا يبقى له من أثر؟
ولما كان الإرث حقًا شرعيًا، قُدِّر بنصٍ قطعي، ونُسج في سويداء العقيدة، فإن من يَحُول دون تسليمه، إنما يقف في وجه إرادة الله قبل أن يقف في وجه الإنسان. إذ كيف يُخيَّل لعاقلٍ أن يحبس رزقًا قُسم بميزانٍ إلهيٍّ دقيق، يُخطئه ميزان البشر ولا يخطئه حكم العزيز العليم؟
لا غرو، فذلك الذي يمنعُ الميراث إنما هو كمَن يطوي صفحة من كتاب العدل، أو يُطفئ سراجًا أضاءه الله في قلوب الورثة، بل هو، بالدرجة الأولى، كمن يتخذ من حبّ المال ربًّا يُعبد من دون الله، فيسجدُ لجشعه، ويصلي لأنانيته، ويُقيم شعائر الطمع على مذبح الدم.
وما انفكّ هذا السلوك ـ في صميمه ـ صورة من صور الظلم المتدرّع بالحيلة، إذ يُخفي الفاعل أنيابه خلف ابتسامةٍ زائفة، ويختبئ خلف شعارات الزهد والنسيان، وهو يعلم يقينًا أنه يسلب من أخيه أو أخته أو يتيمٍ ضعيف، ما هو له حقٌّ مَحض، لا منّة فيه ولا فضل. ولئن كان القرآن قد رسم مشاهد العذاب للكافرين والمنافقين، فإن امتناع المرء عن إعطاء ذي حقٍّ حقَّه، لهو صورة من صور الكفر العملي الذي يُغضب الله، وإن ادّعى صاحبه الطهارة.
في حين يُشَبَّه هذا الفعل الشنيع بما ورد في قوله تعالى: “فمثله كمثل صفوانٍ عليه ترابٌ فأصابه وابلٌ فتركه صلدا”، إذ إنّ عمله ـ في ظاهره ـ برٌّ وصلاحٌ، لكنّه في حقيقته خواءٌ وجفافٌ، لا يُثمر عدلًا ولا يُنبت رحمة. كما يُشَبَّه ـ من جهة أخرى ـ بقوله تعالى: “كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران” الانعام الاية 71، إذ يتخبّط في دروب الظلم، ولا يعرف لنفسه قبلة ولا هدى، يظنّ أنه يحسن صنعًا، وهو في وحلِ الخيانة غارق.
أما من حيث المقارنة بين الفعل والعاقبة، فإن ما يرتكبه من يمتنع عن تسليم الميراث هو من قبيل أن يقتلع من الجدار حجر الرحمة، وأن ينسفَ في قلوب ذوي القربى معنى العدل، فلا يبقى لهم في صدره إلا مرارة الحرمان، ولا في ذاكرته إلا صفحة سوداء، تُنادى عليه يوم الحساب: “اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا” الاسراء الآية 14.
ثم انظر كيف يلوِّن القرآن كل سورةٍ بحكمةٍ وإشارةٍ وإعجاز، فمن سورة يوسف تُستخرج كلمتا “كادوا” و”غلب”، لتُقال على من كاد لأخيه أن يُقصيه عن رزقه، وغلبه على إرثه كما غُلب يوسف على أمره ظلمًا، ومن سورة الكهف تستخرج كلمتا “حُسبانًا” و”خسرًا”، إذ الحاسب للميراث من غير علم، والحاجب له من غير شرع، ما هو إلا خاسرٌ خُدع بوهم الغنيمة.
وحيث إن الامتناع عن تسليم الميراث لا يُعدّ مجرّد فعلٍ مدني يخصُّ العلاقة بين الخصوم، بل هو جريمةٌ تمسُّ البنية الأخلاقية للمجتمع، وتنخر عظام القرابة، وتشيع الفتنة بين الإخوة والأخوات، فقد وجب أن يُجرَّم على مستوى القانون والوجدان معًا، ليكون الرادع زاجرًا، والجزاء رادعًا، والعدالة حاضرةً لا تغيب.
أتراه بعد كل هذا يستحق أن يُدعى أخًا؟ أم أن القرابة التي لا تعرف العدل، هي كالأغصان اليابسة، لا تُظِل ولا تُثمر؟ بل هي كجذعٍ هَشّ، تأكله الأرضة في صمت، حتى إذا ما انكسر، لم يُبكِ عليه أحد.
ولئن كان العدلُ أساس الملك، فإن الإخلال بتوزيع الميراث هو كمن ينقض هذا الأساس حجرًا حجرًا، حتى يتهاوى البناء على رؤوس أهله، وما من ناجٍ منهم، إلا من جعل رضى الله فوق كل درهم، والحق فوق كل طمع.
أولًا: في التعريف بجريمة الامتناع عن تسليم الميراث
ولما كان الميراث في جوهره ليس مجرد مال ينتقل، بل أمانة تُسلَّم، وحقٌّ يُصان، ووصيةٌ تُنفَّذ، فإن الامتناع عن تسليمه لا يُعدّ فعلًا ماديًا عابرًا، بل هو انحرافٌ في المسلك، وانتكاسةٌ في الضمير، وتعدٍّ سافر على ناموس العدالة السماوية والتشريعية؛ إذ إنّ نظام الإرث في الإسلام لم يُشرَّع عبثًا، بل وُضع ليكون ترياقًا ضد الفوضى، وصمام أمانٍ يحفظ وحدة الأسرة، ويُعيد توزيع الثروة بما يضمن التراحم والتكافل.
وفي حين يُخيّل للبعض أن الاستيلاء على تركة الغير هو نوع من “الفطنة” أو “الذكاء العائلي”، فإن الحقيقة أبهى وأقسى؛ أتراه ذكاءً، أم هي خيانة موصوفة بحبر الطمع، مغلَّفة بثوب النسب، كالذئب في جلد الشاة؟ لا غرو أن مثل هذا الفعل لا يُقاس بالمال وحده، بل يُوزن بمقاييس الخسة والخذلان، حيث ينقلب القريبُ عدوًا، ويُصبح الأخُ فاجرًا بحق إخوته، كمن يُوقد نارًا تحت فراش أمه.
ولئن كان التشريع الإلهي قد فصّل قواعد الميراث في سورة النساء تفصيلًا بليغًا، وجعلها مما “فرضه الله” لا مما تُرك للاجتهاد، فقد جاء في محكم تنزيله، مخاطبًا الضمائر الحية:
“آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا، فريضة من الله، إن الله كان عليمًا حكيمًا”؛
أفلا يتدبر العاقّون هذه الآية؟ إذ كيف يتجرأ من علم أن الله هو العليم الحكيم، أن يُخالف فريضته ويغتصب ما ليس له بحق؟
ثم تأمل – أيها القارئ البصير – كيف شبّه القرآن بعض القلوب التي نكصت على أعقابها، فقال:
“كمثل الحمار يحمل أسفارًا”، فهل ترى من يمتنع عن تسليم الميراث إلا كمن يحمل الشرع على ظهره، ثم يُلقيه عند أول محكٍّ أخلاقي؟ بل هو كمن قال فيه المولى:
“كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران”، تائهًا بين غواية الطمع، وخزي الضمير، حتى صار أسيرًا لظلمة النفس، وعبدًا لسلطان المال.
وحيث إن الامتناع عن تسليم الميراث، بالدرجة الأولى، هو تعطيل لحق ثبت بوفاة المورث، وثبَّته القانون بإعلام الوراثة، وفرضه الدين كفرض الصلاة والزكاة، فإنه إذا صدر هذا الامتناع من أحد الورثة مع سبق الإصرار، فقد انقلب من تقصيرٍ مدني إلى جريمةٍ جنائية مكتملة الأركان، تتجسد في الاستيلاء غير المشروع، والتعدي على نصوص مقدسة، وتنكرٍ لمقتضى العدالة.
وقد عرّفه فقهاء القانون الجنائي المعاصرون بأنه: “تصرف عمدي صادر عن أحد الورثة، يتجسد في الامتناع الكلي أو الجزئي عن تسليم الحقوق الإرثية إلى مستحقيها الشرعيين بعد ثبوتها قانونًا، بغية الإضرار أو الكيد أو الاستيلاء غير المشروع”، وهو تعريف وإن كان فنيًّا، إلا أنه لا يرقى إلى وصف الحقيقة كاملة؛ إذ كيف يُختزل الغدر في مجرد تعريف؟ وكيف يُصفّد الألم في قالب قانوني بارد؟
وما انفكَّ هذا الفعل يكشف – كلما وقعت الحادثة – عن وجهه القبيح؛ فهو استغلالٌ سافر لحرمة الرحم، واستقواءٌ موهومٌ على من قُيّدت أيديهم بالعجز أو التواضع، وخيانةٌ للأمانة التي ألقاها الموت في أعناقهم عند ساعة الفقد.
ولقد جاءت آيات كثيرة في الذكر الحكيم، تحمل في طياتها عبارات تكاد تصرخ في وجه من يعبث بحقوق الآخرين، منها قوله تعالى في سورة المطففين:
“ويل للمطففين”[المطففين: 1]، وفي سورة القيامة: “بل يريد الإنسان ليفجر أمامه” [القيامة: 5]،، وكأنها سطورٌ خُطت خصيصًا لوصف من يُطفف في القسمة، ويفجر في الخصومة، ويُزيف الحقيقة في محاضر التركة ومجالس الصلح.
إن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث ليست من جرائم الأموال فحسب، بل هي من جرائم القلوب، وذنوب الضمائر، وهنات المروءة؛ إذ تنمو في الظلام، وتقتات على ضعف القانون أحيانًا، وعلى تواطؤ السكوت أحيانًا أخرى. ولقد أحاطها المشرع المصري – ولا يزال – بتجريم خاص، يعكس إدراكه لخطورة الأمر، وسنأتي على بيانه تفصيلًا في المباحث التالية.
لكن، قبل ذلك، لا بد من أن نُقرّ بأن هذا الامتناع ليس فعلاً فرديًا يُرتكب في لحظة، بل منظومة انحطاطٍ أخلاقي، تُغرس بذرته عند الجحود، ويسقيه الجهل، ويُثمر ظلمًا مستطيرًا، كالشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
فهل بعد هذا من جريرة أشد؟ وهل بعد هذا من ظلم أوقح؟
ثانيًا: النص القانوني المنشئ للتجريم
ولما كان الميراث حقًا مقدسًا، مُستمدًا من شريعة ربانية لا تقبل العبث، ومن منظومة قانونية لا تحتمل التجاهل أو التغافل؛ فقد أبى المشرع المصري إلا أن ينتصر للعدل، ويجتثّ داء الطمع من جذوره، فوضع حدًا لجرائم الكتمان والمراوغة، وصاغ قانونًا عادلًا يضرب على أيدي العابثين، ويردع كل من تسوّل له نفسه التفريط في حقوق الورثة، فجاء القانون رقم 219 لسنة 2017 ليُعدّل بعض أحكام قانون العقوبات، مضيفًا مادة جديدة تنطق بالزجر وتُفصح بالوعيد، وهي:
المادة (49 مكررًا): “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، متى طُلب ذلك منه رسميًا، وثبت امتناعه بغير حق.”
ولا غرو، فإن هذه المادة جاءت كالسيف المسلول على رقاب كل من أضمر الغدر، وخبّأ نية الاستحواذ، وأعرض عن شرع الله وسُنن العدل. إذ إن القانون – في حكمة تُضاهي حكمة لقمان – لم يكتفِ بالتجريم المجرد، بل اشترط لقيام الجريمة مطالبة رسمية من الوريث، وثبوت الامتناع بغير مسوغ قانوني، ليُضفي على الفعل رداء الجريمة، وينزعه من عباءة المجاملات الهشة، والعلاقات العائلية المائعة، التي ما انفكت تُستخدم ذريعةً لإضاعة الحقوق، وتسويف العدالة.
أتراه، من بعد هذا النص الجلي، لا يزال يتكئ على وهم النسب، ويستقوي بأواصر الرحم ليجحد الحقوق؟ إذ كيف يُعذر من استحلّ الميراث، كأنما هو خزائن قارون لا يقسمها إلا من شاء؟
ولئن كان الامتناع عن تسليم الميراث خفيًّا في صورته، فهو جليٌّ في جرمه، يشبه – في خبثه – حال من قال عنهم الحق في سورة البقرة: “وإذ لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون”. فهو كذب يُخفي وراءه مكرًا، ووعدٌ لا يُقصد به الوفاء، تمامًا كما يُوهم بعض الورثة إخوانهم بقبول القسمة، بينما يُبيّتون في أنفسهم نية الاستيلاء والانفراد.
أما في شبهه الثاني، فهو كمثل ما ورد في سورة الكهف: “كمثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن…”، إذ تبدو الجريمة – في ظاهرها – كهدنة أو توافق عائلي، لكنها في جوهرها كمن يسرق من نبع الصفاء، ويعكر ماء المودة، ويغتال الطمأنينة في مهدها.
وقد جاءت عبارات التنزيل المعجز – في كل سورة – تحمل من الجلال ما يليق بهذا السياق، فها هي “الطامة الكبرى” في سورة النازعات، تصلح وصفًا لما يحلّ بالعائلة حين تُغتصب الحقوق، ويُهضم الميراث. وها هي “الزقوم” في سورة الدخان، كناية عن المرارة التي يتجرعها من حُرم نصيبه ظلماً، وكأنما لُقّم جمرة لا تبرد.
ففي حين يُنكر البعض الميراث باسم العرف أو الهيبة أو التقاليد، فإن القانون يرد عليهم بما يشبه صواعق التنزيل، ويُذكّرهم بأن العقوبة ليست حبرًا على ورق، بل هي نذير، كسُورة الواقعة في رهبتها، أو كـ”القارعة” حين تفاجئ الظالم من حيث لا يحتسب.
وهكذا، يُثبّت النص القانوني مقام الميراث في حرم العدالة، ويُنذر المتجرئين عليه بعقاب مستحق، فيكون كما قال تعالى في سورة الحديد: “لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم…”، فالميراث ليس غنيمةً تُختطف، بل حقٌّ يقسم بالسوية، ويُسند بالشرع، ويحرسه القانون.
ثالثاً- أركان الجريمة – البنيان القانوني
إن الجريمة في بنيانها القانوني أشبه ما تكون بالكائن الحي، لا تقوم لها قائمة إلا إذا اكتملت أركانها وتضافرت عناصرها، فهي كالجسد الذي لا يُستَدام بقاؤه إلا إذا التأم عظمه واستقامت أعضاؤه؛ ذلك أن الشرط في العقاب هو تمام البناء، وإلا انفرط العقد وسقط الحد. ولما كان الامتناع عن تسليم الميراث لا يُعَد مجرد تقصير عرضي، بل جرم مقصود ينخر في جسد العدالة، فقد عني المشرع بتحديد أركانه الثلاثة: الركن المادي، والركن المعنوي، وركن مفترض لا غنى عنه.
-: الركن المادي للجريمة
إذ إن ركنها المادي يتمثل في ذلك الامتناع العمدي، الذي يُجسد فعلًا سلبيًا قائمًا على الإحجام المتعمد عن تسليم الحق إلى مستحقه، بعد أن طالبه به رسميًا، وكأن الجاني يقول له بلسان الحال: “اذهب فلن أُعطيك شيئًا”، على نحو لا يختلف في خطره عن نزع الحق قسرًا.
ولئن كان الفعل السلبي يُوهم في ظاهره بالخمول، فإن أثره أشد من وقع السهام، إذ يحرم الوارث من حقه المعلوم، ويدفع به إلى غياهب الخصام والتقاضي، فلا هو استقر في ماله، ولا استرحت نفسه، ولا هدأت روحه.
ويتكوّن هذا الركن من العناصر الآتية:
- السلوك الإجرامي: ويتمثل في الامتناع، وهو صورة من صور النشاط السلبي الذي يُرتب أثرًا جنائيًا، متى اقترن بالقصد والعلم. ولا غرو، فكم من سكوت أشد وقعًا من الصراخ، وكم من إعراض أفدح في جرمه من العدوان!
- النتيجة الضارة: وهي حرمان الوارث من حقه الشرعي في التركة، ولو إلى حين، في مشهد يُشبه ذلك الذي وصفه التنزيل الكريم في قوله تعالى: “ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالًا وعدده، يحسب أن ماله أخلده”، إذ يتوهم الجاني أن المال حصن لا يُهدم، ولا يعلم أنه سبب في ضياعه.
- علاقة السببية: وهي الرابطة التي تربط بين الفعل والنتيجة، بحيث يثبت أن الضرر ما كان ليقع، لولا ذلك الامتناع المتعمد، كالوتر المشدود بين قوسين؛ فإن انفلت طرفه، أصاب سهمه قلب العدالة.
-: الركن المعنوي للجريمة
أما الركن المعنوي، فهو روح الجريمة ومحرّكها الباطني، يتمثل في القصد الجنائي الخاص، أي أن الجاني قد تعمّد حرمان الورثة من حقهم، عالمًا بحقيقة ذلك الحق، ومصممًا على غمطه والاستئثار به، غير آبهٍ بوعيد الشريعة، ولا بسلطان القانون.
فلا يُتصور قيام الجريمة على مجرد إهمال أو جهل، وإنما على نية متأصلة في إزاحة الحق، كمن يُطفئ السراج عمدًا ليضل السائرون، وقد قال الله تعالى في موضعٍ آخر يُشبه هذا الحال: “ومن يَكْتُمْها فإنه آثم قلبه”، فأي كتمان أشد إثمًا من كتمان الميراث؟!
ولئن كان الجاني يُزيّن لنفسه فعله، فليتذكر قول العزيز الحكيم: “بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره”. إذ كيف يُؤتمن من يخون أقرب الناس إليه؟!
-: الركن المفترض
ولما كانت الجريمة لا تُبنى على الوهم، ولا تُقام على غير أساس، فقد اشترط المشرع – بالحكمة التي تنبع من روح الشريعة – وجود ركن مفترض لا تنعقد الجريمة إلا به، ويتمثل في:
- وجود تركة شرعية ثابتة، لا خلاف على قيامها ولا غموض في عناصرها.
- وجود ورثة مستحقين بنصوص القانون وأحكام الشريعة، ممن لا يُختلف على صلتهم أو نصيبهم.
فإذا اختل واحد من هذه الشروط، انحسر الوصف الجنائي، واندحر ركن الجريمة، وعاد النزاع إلى ساحات القضاء المدني، لا الجنائي، كالماء الذي ينحسر عن أرضٍ لم يَنزل الغيث فيها.
وهكذا، فإن هذه الأركان الثلاثة تُشكّل الهيكل الكامل لهذه الجريمة، التي ما انفكت تُهدد النسيج الأسري، وتُبدّد سكينة العدل في المجتمعات، ولولا تدخل المشرّع، لبقي الوارث كالمستجير من الرمضاء بالنار.
أتراك رأيت ظلمًا أشد من أن يُحرم الإنسان من ميراث كُتب له في لوح القدر، وأقَرّته الشريعة، وثبّته القانون؟!
أم ترى أن الجشع حين يعمى، لا يترك لصاحبه بصيرة، ولا لغيره نصيبًا؟!
رابعًا: شروط قيام الجريمة :
ولئن كانت جريمة الامتناع عن تسليم الميراث لا تقوم إلا على دعائم قانونية صلبة، فإن شرطين لا مندوحة عنهما في تشييد بنيانها القانوني: أولهما، قيام مطالبة رسمية قاطعة لا لبس فيها؛ وثانيهما، امتناع صريح لا يحتمل التأويل. وهذان الركنان – وإن بديا في ظاهر القول بسيطين – فإنما هما في جوهرهما كالسيفين المسنونين، يشقان غشاء الشبهة، ويستأصلان العذر، حتى لا يبقى للمدعى عليه ملاذ منكر ولا ملجأ متذرع.
1: شرط المطالبة الرسمية
حيث إن المطالبة الرسمية تمثل صوت الحق حين يُرفع في وجه الجحود، فإنها لا تكون كذلك إلا إذا صدحت بنغمة الشرع والقانون، معلنة على وجه لا يخالطه التباس، أن للوارث حقًا معلومًا، وأن ثمة من اعتدى عليه صمتًا أو جحودًا أو تجاهلًا. وإذ إن الحقوق لا تُنتزع من بين أنياب الإنكار إلا بسيف العدالة، فإن توجيه إنذار قضائي موثق، أو إقامة دعوى واضحة المعالم، هو السبيل القويم الذي لا غبار عليه، لإثبات علم الجاني يقينًا بوجود حق مستحق ومطالب به.
فالحق، إن لم يُطالب به علنًا، صار كالماء الراكد، لا يُعرف له منبع ولا مصب، ولا يُمكن أن يُحتج به على من أنكره؛ إذ كيف يُحاسب المرء على امتناع لم يعلم به، أو دعوى لم تُقرع سمعه بها؟! وهل يستوي في ميزان العدل من بُيّن له الحق جليًا، ومن غُمّت عليه السُبل؟!
ولما كان الحق لا يُسترد إلا بالمطالبة الواضحة والمباشرة، فإن هذا الطلب – الذي يضع النقاط على الحروف – يجب أن يتسم بالوضوح والشمول، بحيث لا يحتمل أي لبس أو تأويل. إذ إن المطالبة الرسمية، سواء أكانت تتمثل في إنذار قضائي أم دعوى موثقة، هي الأداة القانونية الوحيدة التي تكفل للوارث حقه بلا منازع، وتفرض على الجاني تسليم الحق في ظل إشعار علني، لا يُقبل فيه التردد أو التباطؤ.
ومن ثم، فإن الميراث لا يُنتزع عنوة، ولا يُستولى عليه بخفاء، بل يجب أن يكون هناك مطالبة واضحة، قد تكتسي هيئة إنذار رسمي يوجه إلى الجاني، ليُعلم علم اليقين بحقه الثابت، وبأن مماطلته في تسليم الميراث ليست إلا تلاعبًا بمصير أرواح، وعبثًا في استقرار الحقوق. ولا غرو في أن هذا الإنذار يجب أن يكون مُوقعًا من الجهة المختصة، ليضفي عليه قوة قانونية نافذة، لا يدع مجالًا لأي محاولة للنكران أو التملص.
وإذ كان هذا الإنذار قد أُرسل، فإنه يصبح الوسيلة القانونية التي تُثبت وقوع المطالبة في حق الجاني، ويُثبت من خلالها أن المطالبة قد أُبلغت إليه بصفة قانونية لا تحتمل التشكيك. هكذا، تُفرض على الجاني مسؤولية الرد الفوري، إما بالامتثال لتسليم الميراث، وإما بالرفض المعلن الذي سنأتي على توضيحه في لاحقًا.
2: شرط الامتناع
أما الامتناع، فهو اللبنة التي يُبنى بها الركن المادي للجريمة، لا على سبيل الخطأ أو الغفلة، بل على صورة العمد والاستكبار؛ إذ هو فعل سلبي ذو وقع مؤلم، كمن أغلق الباب في وجه السائل المستحق، أو كمن أطفأ المصباح في درب يسير فيه العدل ليلًا، فيتعثر. ولا غرو، فإن الامتناع عن تسليم الحق بعد المطالبة الرسمية، هو بمثابة صد عن سبيل الميراث المشروع، وصدٌّ عن إقامة القسط بين الناس.
ولما كان هذا الامتناع لا يتحقق إلا مع توافر الإرادة الحرة، والعلم اليقيني بوجود التركة والمستحق، فإن من يدعي الجهل أو النسيان، إنما هو كمن يستتر خلف ستار واهن، سرعان ما تُمزقه يد التحقيق وتبدده أنوار المحاكمة العادلة.
أما عن إثبات الرفض، فذلك الأمر لا يُحتمل فيه الشك أو الهفوات، وإنما يتطلب دقة متناهية في جمع الأدلة التي تُثبت عدم الاستجابة للمطالبة، ويكون ذلك بالطرق القانونية التي تضمن توافر الأركان الجوهرية للجريمة.
إذ إن الرفض ليس مجرد تلميح أو إشارة ضمنية، بل هو فعل جلي لا يحتاج إلى تفسير، بحيث يتم التأكد من أن الجاني قد علم علم اليقين بالطلب الموجه إليه، ومع ذلك امتنع عن تسليم الميراث، مع علمه التام بأن هذا التصرف يمثل اعتداء على حق مشروع للوارث. ولما كان الامتناع هنا فعلًا سلبيا، فإنه يُقاس بعين الاعتبار على أنه تقاعس عن القيام بفعل إيجابي كان من الواجب عليه القيام به، وكأنما هو إغلاق للباب في وجه المستحق بعد أن سُمح له بالدخول.
ولئن كان الجاني قد تمت مطالبته رسميًا، ورفض تسليم الميراث علنًا أو ضمناً، فإن المحكمة – في سياق محاكمتها – ستُفحص كافة الأدلة والشهادات التي تُظهر إصرار الجاني على الرفض، سواء كان ذلك بتقديم مستندات رسمية تظهر تعطيله لعملية تسليم الميراث، أو بإحضار شهود يشهدون على أن الميراث قد امتُنع عن تسليمه رغم مطالبته به. ولا ينحصر الرفض فقط في إظهار الجحود بالنص المكتوب، بل يمتد إلى المواقف التي يمكن أن تُظهر تعطيل الحق بأي صورة كانت، سواء كان ذلك بتأخير الإجراءات القانونية أو بتجاهل المطالبات الرسمية.
وفي هذا السياق، فإن الاعتماد على الشهادات الحية من الأطراف المعنية أو أي تواصل رسمي مع الجاني يُعد من أبرز وسائل إثبات الرفض. مثلًا، إذا ثبت أن الجاني قد تسلّم إنذارًا قضائيًا بالاستلام وامتنع عن الرد أو تعمّد عدم الاستجابة، فإن ذلك يُعد دليلاً قاطعًا على الرفض المتعمد، ويُصبح التراخي في تسليم الميراث محط مساءلة جنائية.
وما انفك الامتناع عن الاستجابة للمطالبات الرسمية يتخذ طابعًا من التحدي الصريح لسلطة القانون، ويُظهر الجاني في موقف من يستعلي على العدالة، ويساوي في قلبه بين الحق والباطل، مما يجعله أمام القضاء لا محالة موضعًا للمحاسبة الجنائية الصارمة.
خامسًا : العقوبة
المادة (49 مكررًا): “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، متى طُلب ذلك منه رسميًا، وثبت امتناعه بغير حق.”
لأن الجُرم لا يقتصر على كونه فعلًا مخالفًا، بل يتعدّى ذلك ليكون طعنًا في خاصرة العدالة، وتمزيقًا لوشائج الرحم، وعبثًا بأواصر الأسرة التي قامت على الودّ والتراحم، فقد ألبسه المشرّعُ المصري لباس الردع، وأحاطه بسياج العقاب، ليُقيم به ميزان الحق، ويُعيد إلى المواريث حرمتها ووقارها. إذ كيف يُترك من اغتصب أنصبة الورثة يتفيّأ ظلال المال الحرام، في حين يقبع المستحقون في عراء الحاجة وانكسار الخذلان؟
ولذلك، جاء نص المادة (٤٩ مكررًا) من قانون العقوبات، ليُسلّ سيف القانون على رقاب المعتدين، حاسمًا بحدّ النص، قاطعًا لسبيل التحايل والسطو، ففرض عقوبة مزدوجة، تدور على محورين:
ولئن حمدنا للمشرّع التجرؤ على كسر جدار الصمت، وتجريم السطو على التركة، فإننا لا نستطيع أن نغضّ الطرف عن قُصور العقوبة، وتواضع الردع. إذ كيف يُعقل أن تكون عقوبة من يسطو عمدًا على إرث غيره، فيحجب المال عن اليتيم، ويُجري دمع الأرملة، ويقهر الضعيف، لا تتجاوز ستة أشهر حبسًا؟ أليس هذا ما يُفضي إلى وقف التنفيذ غالبًا، وذوبان أثر العقوبة في رمال الإجراءات؟ إنه تساهل لا يليق بجريمة متفشّية، تمسُّ النسيج الأسري، وتكسر العمود الفقري للعدالة الاجتماعية، في وقت بات فيه الإرث يُختطف لا يُوزّع، وتُحرَق فيه المواثيق قبل الوثائق، وتتآكل فيه الصلات في حضرة الطمع.
وإذ نقرع باب المشرّع بنداء واجب، فإننا نوصي بتعديل مدة الحبس لتكون لا تقل عن سنة، على الأقل، منعًا لوقف التنفيذ، وإعمالًا لروح الردع، صونًا للحق، وهيبة للقانون. بل ونذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فندعو إلى إدراج ظروف مشددة بنص المادة، تُغَلّظ العقوبة وتكشف عن مدى جسامة الفعل في بعض الصور، ومن ذلك: إذا كان الجاني ممن وُكّل قانونًا أو عرفًا بتصفية التركة أو تقسيمها، لأن في ذلك خيانة للأمانة وضربًا مضاعفًا للثقة المجتمعية. وإذا وقع الفعل على أنصبة قُصّر أو نساء أرامل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن الجريمة هنا تمسّ الضعفاء، فتغدو مضاعفة في الإثم والأثر. وإذا ارتُكب الفعل باستخدام التزوير أو تحريف المستندات الرسمية، لأن اللجوء إلى التزوير يضرب في صلب الأمان القانوني ويشكّل جريمة مركّبة. وإذا تكرّر الفعل من الجاني، أو كان معتادًا على حجب أنصبة الورثة في أكثر من واقعة، وهو ما يكشف عن خطر إجرامي دائم يتطلب عقابًا مشدَّدًا. وإذا اقترنت الجريمة بتهديد أو استعمال القوة لمنع الورثة من المطالبة بحقوقهم، فتحولت من اعتداء مالي إلى عنف جسدي أو معنوي.
أما أشد الصور فتكًا وإيلامًا، فهي تلك التي يُطرد فيها أحد الورثة من العقار الموروث، وهو لا يملك غيره، فيُقتلع من مأمنه، ويُنتزع من مأواه، ويُلقى في العراء بلا ذنب سوى أنه ضعيف، أو لأنها أنثى لا تجد سندًا إلا عدالة السماء. وهنا، يبلغ الجُرم ذروته إذا كان الطارد أخًا أو قريبًا، فينقلب الحِمى إلى جحيم، والرحم إلى سكين. إنها صور دامغة تستدعي من المشرّع تجريمًا صريحًا، وعقابًا صارمًا، يضع لكل صورة جزاءها، ويضرب بيد العدالة على يد كل من تسوّل له نفسه النيل من الحقوق باسم القرابة، أو التلاعب بمصائر الناس باسم الميراث.
الخاتمة
إن تجريم هذا الفعل المشين لا يجب أن يكون إجراءً شكليًا، بل ردعًا حقيقيًا، يصون الأواصر ويكبح الطمع، ويجعل من العدالة مظلة واقية للمظلوم، لا سيّما إن كان يتيمًا أو امرأةً لا ناصر لها. فالميراث، في ضمير الشرع والقانون، ليس منحةً يُعطى بها أو يُمنع، بل حقٌّ واجب، لا يملك أحدٌ مصادرته ولا حجبه.
أما كفاك أن تأكل مال اليتيم ظلمًا وعدوانًا؟! أما ارتجفت أطرافك من دعوة مظلوم سهّدها الحرمان وأوقدها القهر؟! إن الميراث الذي حجبته بيدك، ليس مالًا فحسب، بل حقٌ مُقدّس، وجزءٌ من قَسمةِ الله التي لا يجرؤ على منازعتها إلا معتد أثيم، قاسي القلب، ميت الضمير، جاحد لما أمر الله به أن يُوصَل.
إنك – أيها الممتنع المتجبر – لا تقتسم رزقًا، بل تبتلع النار ببطء، وتزرع شوكًا في طريقك، ستجده يحاصرك يوم لا ينفع مالٌ ولا جاهٌ ولا نسب. أفلا تتعظ؟! أما قرأت في الكتاب العزيز:
{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}؟!
فأيّ نارٍ تلك التي تتلظى في الجوف، وتشتعل في القلب، وتُسعّر في الدار والدار الآخرة؟!
ألا إن من يمنع الميراث، كمن يقطع شجرة النسب، ويهدم أعمدة العدل، ويطفئ مصباح الرحمة من بين عينيه، فلا يُبقي لصلات الدم حرمة، ولا لضعف الأرامل عذرًا، ولا لصوت اليتامى أذنًا صاغية. هو الذئب في ثياب البشر، والنهّاش في لحم الأقارب، والناهب في صمت الضمائر.
إن الحقوق الموروثة لا تسقط بصمت الورثة، بل هي كالماء المحتبس خلف السدّ، لا بد أن ينفجر يومًا، فإن لم ترده اليوم طواعية، فسيُنتزع منك غدًا عنوة، وستُحاكم أمام عدالة الأرض وعدالة السماء، وستبكي دمًا لا دموعًا، ويومها لا ينفعك مالٌ، ولا يُغني عنك فقهٌ، ولا تنفعك شفاعةٌ من أحد.
فأفِقْ، وأعِد الحقّ إلى أهله، قبل أن يُصبح ميراثك لعنةً عليك، ووصمةً تلاحق اسمك في حياتك وبعد مماتك، وتكون خصيمك فيه أرحامٌ قطعتها، ووجوهٌ سلبتها، وقلوبٌ كسرتها.
فيا من حجبت الميراث: تبْ قبل أن تُحجَب عن رحمة الله، وردّ الحق قبل أن تُسأل عنه بين يديه، فما الميراث في ميزان الشرع مالًا فحسب، بل هو ميثاق عدلٍ، وحُكم قَدَر، وحقٌّ لا يزول بتقادم ولا بجبروت، وإن طال ليل الظلم، فإن فجر العدل آتٍ لا محالة.
التوصيات
نص مقترح لمادة قانونية لتجريم الامتناع عن تسليم الميراث وتغليظ العقوبة في حالات خاصة
المادة (49 مكررًا – مقترحة):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من امتنع عمدًا، دون مقتضى من القانون، عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من التركة، متى طُلب ذلك منه رسميًا، وثبت امتناعه بغير حق.
وتُضاعف العقوبة في الأحوال الآتية، وتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه:
- إذا كان الجاني ممن أوكل إليه قانونًا أو عرفًا أمر تصفية التركة أو تقسيمها، فخان الأمانة واستولى على النصيب لنفسه أو لغيره.
- إذا وقع الفعل على أنصبة قصّر، أو نساء أرامل، أو أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لما في ذلك من غدر واستغلال للضعف.
- إذا ارتُكب الفعل باستخدام وسائل التزوير أو التحريف في الأوراق الرسمية أو العرفية المتعلقة بالميراث.
- إذا تكرّر الفعل من الجاني، أو كان معتادًا على حجب أنصبة الورثة في أكثر من واقعة، بما يكشف عن نمط إجرامي معتاد.
- إذا اقترنت الجريمة باستعمال التهديد أو القوة لمنع الورثة من المطالبة بحقوقهم، أو نتج عنها حرمان كلي لأحدهم من نصيبه، أو طرده من عقار موروث يُعدّ مسكنًا وحيدًا له، لاسيما إذا كان المتضرر أنثى أو يتيمًا لا عائل له، لما لذلك من أثر بالغ القسوة في النفس والمآل.
تُضاف إلى العقوبات الأصلية، بحسب الأحوال، العقوبات التكميلية التالية:
- الحرمان المؤقت من الحقوق المدنية والسياسية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، صونًا لردعٍ عام ومظهرٍ علني للعدالة.
- الحرمان من التوكيل أو الوصاية أو القوامة مستقبلاً متى ثبتت إساءة استعمال الحق في الإرث.
- إلزام الجاني بردّ الأنصبة المغتصبة وردّ الثمار أو الريع الناتج عنها، مع تعويضٍ عادلٍ عن الضرر المادي والمعنوي.
التدابير الاحترازية المقترحة:
- إنشاء وحدة قضائية متخصصة في منازعات التركات لتسريع إجراءات التقسيم والبت في القضايا.
- اعتماد رقمنة إعلامات الوراثة وبيانات توزيع التركة وربطها إلكترونيًا بمصلحة الشهر العقاري والأحوال المدنية والبنوك، لضمان الشفافية والتوثيق.
- إنشاء صندوق دعم قضائي لضحايا حجب الميراث غير القادرين على التقاضي، تحت إشراف وزارة العدل.
التوصيات المجتمعية والتربوية:
- دعوة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية إلى تفعيل دور المنابر الدينية في توعية الناس بخطورة حجب الميراث شرعًا ودينًا، باعتباره أكلًا للسحت وقطعًا للرحم.
- إلزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ببث حملات توعوية منتظمة، تُبرز الآثار النفسية والقانونية للجريمة، وتُعلي من ثقافة احترام الحق الشرعي للمرأة والضعفاء في الإرث.
- إدراج مفاهيم العدالة الميراثية ضمن مناهج التعليم في مراحل الإعدادي والثانوي والجامعي، خاصة في كليات الحقوق والآداب والتربية.
- تنظيم حملات توعية ميدانية بالشراكة بين الجمعيات الأهلية والجامعات والمجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان، لضمان وصول الرسالة للقرى والنجوع.
- إنشاء رقم ساخن وشكاوى إلكترونية داخل وزارة العدل لتلقي بلاغات الامتناع عن تسليم الميراث وتقديم الدعم القانوني للمتضررين.