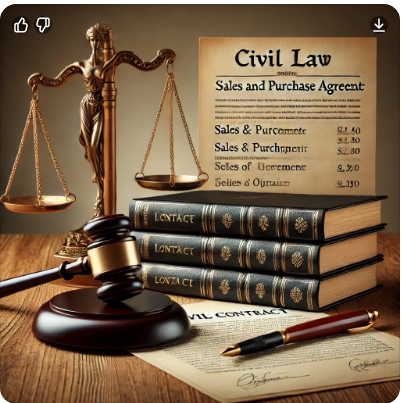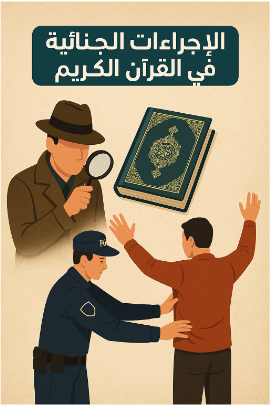أولا:تمهيد
لا غرو أن المدينة الحديثة، بما تزخر به من كثافةٍ سكانيةٍ متزايدةٍ، ونموٍّ عمرانيٍّ متسارعٍ، وتكدسٍ مروريٍّ محتدمٍ، قد أفرزت ظواهر اجتماعيةً متباينةً، بعضها جاء استجابةً لحاجاتٍ موضوعيةٍ اقتضتها الطبيعة الديناميكية للحياة الحضرية، وبعضها الآخر ما انفك يتكئ على الفوضى، ويتمدّد بغير قيدٍ ولا ضابطٍ، حتى أضحى عبئًا على النظام العام، ومعول هدمٍ لقواعد الانتظام العمراني التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة.
ولما كان التنظيم المروري يشكّل أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها العمران المتحضر، وحيث إن ضبط حركة المركبات وضمان سلاسة تدفّقها في الطرقات العامة يُعدّ من صميم مقتضيات النظام العام، فقد برزت ظاهرة “السّايس“، التي أتراها قد نشأت في أصلها استجابةً لحاجةٍ ملحّةٍ لتنظيم أماكن وقوف السيارات، غير أنّها ما انفكت تخرج عن هذا الإطار، إذ كيف أمست في مواضع كثيرةٍ صورةً من صور الاستيلاء على الفضاء العام بغير وجه حقٍّ، وفرض الإتاوات دون سندٍ من القانون، واستعراض القوة بأساليب أقرب إلى فرض الهيمنة منها إلى تقديم الخدمة؟ ولئن كان الأصل في هذه الظاهرة أن تكون امتدادًا لنظامٍ مروريٍّ منضبطٍ، خاضعٍ لإشراف الدولة، فإنها تحوّلت في كثيرٍ من الأحيان إلى نوعٍ من الفوضى المنظمة، حيث يجد المواطن نفسه أمام أفرادٍ نصّبوا أنفسهم أوصياء على الشوارع، يفرضون عليها سطوتهم، ويبتزّون المارّة بغير حقٍّ، فإن هم امتثلوا، سلموا من أذاهم، وإن هم رفضوا، تعرضوا لتهديدٍ مستترٍ أو صريحٍ، قد يتطور إلى عنفٍ أو إتلافٍ للممتلكات. وإذ كيف يكون للنظام العام أن يستقيم، وللمشروعية أن تبسط سلطانها، إذا ما تُرِك المجال لمثل هذه الممارسات أن تستشري بلا رادعٍ، فتُخضع المجال العام لمنطق القوة بدلًا من منطق القانون؟ وحيث إن الدولة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم وإدارة المرافق العامة، فلا يجوز لفردٍ أو جماعةٍ أن يفرضوا أنفسهم سلطةً بديلةً، خارج أُطُر الشرعية، بما يستوجب وضع تشريعٍ صارمٍ يكفل القضاء على هذه الظاهرة، وردع من تسوّل له نفسه الاستهانة بالنظام العام، وامتهان سيادة القانون.
ثانياً:التعريف اللغوي للسايس وأصل الكلمة
جاء في لسان العرب لابن منظور أن “السائس” هو من يسوس الدواب، أي يقوم برعايتها وتدريبها والقيام بشؤونها، وكما يسير الراعي بقطيع الغنم حيث شاء، فإن السائس يسير بدوابه كيفما أراد، يملك زمامها، ويوجهها في المسار الذي يختاره، وهو في ذلك كمن ينسج خيوط العنكبوت حول فريسته، يُحكم قبضته عليها، فلا فكاك لها من سطوته. وكلمة “ساسَ” في أصلها اللغوي تعني التدبير والرعاية، ومنه قيل: “ساسَ الأمرَ” أي دبره وتولى شؤونه، كما يدبّر الملاح سفينته وسط لجة البحر، فإن أحسن القيادة نجا ونجا معه من على متنها، وإن أفسد تدبيره، هوت السفينة بمن فيها إلى الأعماق.
ويقال “سُوِّسَ الرجلُ” أي جُعل واليًا ومسؤولًا، وهو كمن يُلقى في يده لجام الأمور، فإن كان حكيمًا قادها إلى بر الأمان، وإن كان طاغية، كان كمن يفتح سدود الماء العارم على الحقول، لا يترك خلفه إلا الخراب. أما من حيث الاشتقاق، فكلمة “سائس” مشتقة من الجذر “س و س”، الذي يدل على القيادة والإدارة والتدبير، ولهذا سُمِّي الحاكم “سيِّدًا” لأنه يسوس الرعية، كما ورد في المعاجم القديمة. وفي الحديث النبوي الشريف: “كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء”، أي يتولون تدبير أمورهم وقيادتهم، كما يقود الفارس جواده في ساح الوغى، فإن كان فارسًا ماهرًا قهر أعداءه، وإن كان ضعيفًا أو متخاذلًا، سقط تحت سنابك الخيل.
ثالثاً:تطور الدلالة اللغوية إلى المعنى الحديث
مع تطور الزمن، انتقل مدلول الكلمة من سياق رعاية الدواب إلى مجال تنظيم حركة المركبات، حيث أصبح “السائس” يطلق على الشخص الذي يتولى تنظيم وقوف السيارات في الشوارع والمواقف العامة، لكنه لم يلبث أن تحوّل – في بعض السياقات – إلى مخلوقٍ آخر، كذئبٍ يرتدي جلد الحمل، يموّه على الناس بحسن صنيعه، حتى إذا ما استبدّ به الجشع، ظهر على حقيقته، كالمفترس الذي ما إن يرى الفريسة وحيدة حتى ينقضّ عليها بلا رحمة.
ولئن كان السايس في أصله أشبه بالحارس الذي يُناط به حفظ النظام، فإن بعضهم قد قلبوا الموازين، فصاروا كمن أُوكل إليه حماية القلعة، ففتح أبوابها للغزاة، ينهبونها ويستبيحون خيراتها دون رادع. فبدلًا من أن يكون التنظيم هو هدفهم، غدوا كمن يتقاسمون الغنائم، كلٌّ يفرض سيطرته على رقعةٍ من الأرض، لا يمرّ بها أحد إلا بعد أن يدفع ضريبة المرور، كأنهم نصّبوا أنفسهم سلاطين على مملكة الأرصفة، يحكمونها بيدٍ من حديد.
رابعاً:المصطلح في السياق القانوني
ولئن كان الأصل في “السائس” أنه شخصٌ يتولى مهامًا تنظيمية في الفضاء العام، فإن التحريف الذي لحق بالدلالة جعله يتماهى في بعض الأحيان مع صورة “المُتغلب على الطريق”، فيتحوّل من منظمٍ إلى متحكمٍ، ومن خادمٍ للمرفق العام إلى مستبدٍّ به، فارضًا رسومًا وإتاواتٍ بلا سندٍ قانوني، تمامًا كالسيل العرم الذي يبدأ بقطراتٍ صغيرة، سرعان ما تتحول إلى طوفانٍ يهدم السدود، ويجرف معه كل ما يعترض طريقه.
وإذ كيف يكون لمرفقٍ عامٍّ أن يتحوّل إلى ميدانٍ يُرتهن فيه أمن المواطن وراحة باله لنزوات الأفراد وأهوائهم؟! ولئن كان التنظيم المروري في جوهره يهدف إلى ضبط حركة السير وضمان الانتفاع الأمثل بالطرقات، فقد غدا في ظل هؤلاء طقسًا من طقوس الجباية القسرية، حيث يُفرض على كل سائقٍ أن يدفع وكأنه يؤدي جزيةً عن مركبته، لا مهرب له منها ولا فكاك، فإن لم يمتثل، عوقب بسيارته، كمن يعاقب العبد بعصيان سيده، يُترك نهبًا للعقاب الصامت، خدوش هنا، وإطارات ممزقة هناك، وكأنها رسالةٌ لا تحتمل التأويل: “إما أن تدفع، وإما أن ترى مركبتك تذروها رياح الغضب”.
ولما كان مناط سيادة القانون أن يكون النظام هو الحَكَم، والعدل هو الفيصل، فإن تفشي هذه الظاهرة يُنذر بتآكل هيبة الدولة، إذ لا يعقل أن يضطر المواطن إلى استرضاء شخصٍ لا يملك صفةً رسميةً، فقط كي يحظى بحقه الطبيعي في التوقف الآمن. ومن عجبٍ أن بعض هؤلاء السايسين لا يقفون عند حد طلب المال، بل تراهم يستعرضون عضلاتهم، يملكون من استعراض القوة ما يرهق النفوس، وكأنهم يستمدون سلطانهم من قانون الغاب، حيث لا صوت يعلو على صوت الأقوى، فيغدون كالمارد الذي خرج من قمقمه، لا يرضى إلا أن يحكم، ولا يقبل إلا أن يُطاع.
ولئن كان كتاب الله قد شبّه الاعتداء على الحقوق بامتداد النار في الهشيم، فإن هذه الظاهرة لا تختلف في أثرها عن تلك النار التي تلتهم الأخضر واليابس، تهدد السلم المجتمعي، وتشيع الفوضى التي لا ينضبط لها ميزان، فما أشبه حال بعض هؤلاء بمن قال فيهم القرآن: “كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ” (المنافقون: 4)، يتوارون خلف قناع الخدمة، بينما هم في حقيقتهم عالة على المجتمع، يتغذون على خوف الناس وترددهم.
وما انفك الأمر يتفاقم، إذ لم يعد التعدي مقتصرًا على فرض الإتاوات، بل غدا يمتد إلى تهديد الممتلكات وإلحاق الضرر بالمركبات، حتى أصبح المواطن، كلما همّ بركن سيارته، كمن يضع ماله في مهبّ الريح، لا يدري أيرجع إليه سالمًا، أم يجده وقد عبثت به أيادي الطمع والغطرسة، وكأنما ألقى بمتاعه في بحرٍ لُجّيٍّ، تتلاطمه أمواج الظلم، فلا يدري هل يسلمه الموج إلى بر الأمان، أم يلقي به إلى هاوية الضياع.
وحيث إن التشريعات القائمة قد لا تكفي لمواجهة هذه الظاهرة بمختلف أوجهها، فقد بات لزامًا أن يُستحدث نصٌّ قانونيٌّ صارمٌ، يضع حدًّا لهذه التجاوزات، ويُحكم قبضة الدولة على الفضاء العام، حتى لا يُترك نهبًا لمن لا خلاق لهم، ممن يتخذون من الشارع مسرحًا للبلطجة، ومن المواطنين هدفًا لابتزازهم المستتر والصريح، فإن لم يردعهم القانون، فلا عجب أن ينتهي الحال بالمجتمع إلى أن يصبح “كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا”، لا ينفعه علمٌ، ولا تؤتيه تشريعاتٌ ثمارها.
خامساً:حيثيات الظاهرة: بين التنظيم والتسلط
ولا جرم أن هذه الظاهرة، إذ تلبّست برداء الخدمة العامة، سرعان ما تحوّلت إلى سلوكٍ يعبق بشتى صور التغوّل على الحقوق، حيث إن السايس لم يعد مجرد عاملٍ ينظم حركة المركبات، بل صار – في بعض الأحوال – مستبدًا صغيرًا، يمارس سلطةً لا مستند لها من قانون، يتعامل مع الطرقات وكأنها ضيعةٌ يقتطعها لنفسه، يمنح حق التوقف لمن يدفع، ويُذيق الويلات لمن يمتنع.وإذ كيف يكون لمرفقٍ عامٍّ أن يتحوّل إلى ميدانٍ يُرتهن فيه أمن المواطن وراحة باله لنزوات الأفراد وأهوائهم؟! ولئن كان التنظيم المروري في جوهره يهدف إلى ضبط حركة السير وضمان الانتفاع الأمثل بالطرقات، فقد غدا في ظل هؤلاء طقسًا من طقوس الجباية القسرية، حيث يُفرض على كل سائقٍ أن يدفع وكأنه يؤدي جزيةً عن مركبته، لا مهرب له منها ولا فكاك.ولما كان مناط سيادة القانون أن يكون النظام هو الحَكَم، والعدل هو الفيصل، فإن تفشي هذه الظاهرة يُنذر بتآكل هيبة الدولة، إذ لا يعقل أن يضطر المواطن إلى استرضاء شخصٍ لا يملك صفةً رسميةً، فقط كي يحظى بحقه الطبيعي في التوقف الآمن. ومن عجبٍ أن بعض هؤلاء السايسين لا يقفون عند حد طلب المال، بل تراهم يستعرضون عضلاتهم، يملكون من استعراض القوة ما يرهق النفوس، وكأنهم يستمدون سلطانهم من قانون الغاب، حيث لا صوت يعلو على صوت الأقوى.ولئن كان كتاب الله قد شبّه الاعتداء على الحقوق بامتداد النار في الهشيم، فإن هذه الظاهرة لا تختلف في أثرها عن تلك النار التي تلتهم الأخضر واليابس، تهدد السلم المجتمعي، وتشيع الفوضى التي لا ينضبط لها ميزان. وما انفك الأمر يتفاقم، إذ لم يعد التعدي مقتصرًا على فرض الإتاوات، بل غدا يمتد إلى تهديد الممتلكات وإلحاق الضرر بالمركبات، حتى أصبح المواطن، كلما همّ بركن سيارته، كمن يضع ماله في مهبّ الريح، لا يدري أيرجع إليه سالمًا، أم يجده وقد عبثت به أيادي الطمع والغطرسة.وحيث إن التشريعات القائمة قد لا تكفي لمواجهة هذه الظاهرة بمختلف أوجهها، فقد بات لزامًا أن يُستحدث نصٌّ قانونيٌّ صارمٌ، يضع حدًّا لهذه التجاوزات، ويُحكم قبضة الدولة على الفضاء العام، حتى لا يُترك نهبًا لمن لا خلاق لهم، ممن يتخذون من الشارع مسرحًا للبلطجة، ومن المواطنين هدفًا لابتزازهم المستتر والصريح.
سادساً: تحليل قانوني وفق أركان الجريمة
إن ما يمارسه بعض السايسين من فرض السيطرة على الطرقات، واستعراض القوة على السائقين، وفرض الإتاوات بغير سند قانوني، لا يخرج عن كونه صورة من صور جريمة البلطجة المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، لا سيما في المادة 375 مكرر، التي جاءت لمكافحة الأفعال التي تقوم على الترهيب والتخويف بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.
ولما كانت الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة: الركن المادي، الركن المعنوي، والركن الشرعي، فسنقوم بتفصيل تطبيقها على الأفعال التي يرتكبها بعض السايسين المخالفين، لنثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنهم تحت طائلة القانون، وأن ما يقومون به لا يخرج عن كونه صورة من صور الفوضى المنظمة التي تستوجب العقاب الرادع.وقد جاء النص القانوني واضحًا في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري، حيث نصّت على أنه:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدامها، أو استخدام القوة ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أذى مادي أو معنوي به، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو لإرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وذلك متى كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه وسكينته، أو تعريض حياته وسلامته للخطر.”
ويُفهم من هذا النص أن أي شخص يستعرض القوة أو يُلجئ غيره إلى الدفع أو الطاعة عبر التخويف يقع تحت طائلة هذا القانون، مما يعني أن السايس الذي يفرض على السائقين مبالغ دون وجه حق، ويهددهم بالإيذاء أو الإضرار بمركباتهم، يُعدّ مرتكبًا لجريمة البلطجة، لأن فعله يستهدف إرغام السائق على دفع مالٍ ليس مفروضًا قانونًا، تحت وطأة التهديد المبطن أو الصريح.
1: الركن المادي للجريمة
الركن المادي هو الهيكل الخارجي للجريمة، ويقوم على ثلاثة عناصر: السلوك الإجرامي، والنتيجة الإجرامية، وعلاقة السببية بينهما.
– السلوك الإجرامي (الفعل المرتكب من السايس) يتخذ السلوك الإجرامي للسايس عدة صور، منها:- استعراض القوة: حيث يقف السايس في وضع يوحي بالسيطرة والهيمنة، مستخدمًا ألفاظًا أو إشارات توحي بوجوب الدفع، وكأنه المالك الحصري للمكان. – التهديد الضمني أو الصريح: كأن يلوّح السايس للسائقين بأن رفضهم للدفع سيعرض سياراتهم للخدش، أو للإضرار بالإطارات، أو حتى للتجمهر حولهم في صورة ترهيبية. – فرض إتاوات غير قانونية: إذ يطلب من السائق مبلغًا ماليًا دون أي سند قانوني، وكأنه يفرض رسومًا لا تُعرف لها شرعية. – إلحاق الأضرار بالمركبات: فإذا ما رفض السائق الدفع، قد يعود ليجد سيارته وقد لحقت بها أضرار، وكأنها عقوبة غير معلنة على امتناعه عن “الخضوع”. -التهديد والترويع: إذ يقف السّايس متحفزًا، مُظهرًا علامات القوة، ليزرع في نفوس السائقين خوفًا خفيًا، يجعلهم ينصاعون له دون مقاومة، في مشهدٍ يذكّرنا بقول الله تعالى: “يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ” (الحشر: 4)، إذ إنه يضع نفسه في موضع القوة الكاذبة، غير مدركٍ أنّ العقوبة متربصة به. -فرض الإتاوات: حيث يفرض رسومًا على السائقين دون وجه حق، مستخدمًا عباراتٍ توحي بأن الدفع “إلزامي”، بينما هو في الحقيقة محض ابتزازٍ لا يسنده نص قانوني. الإضرار بالمركبات: فإذا ما رفض السائق الدفع، لم يجد بُدًّا من أن يعود إلى سيارته ليجدها مخدوشة، أو إطاراتها مُفرغة من الهواء، وكأنّ السّايس يقول له: “هذا جزاء من عصى”، غير أنه في حقيقة الأمر ليس سوى نموذجٍ لقمة الاستبداد، الذي لا يلبث أن ينهار متى ما استقامت الدولة على سيادة القانون. -التجمّع الاستعراضي: إذ يتخذ بعض السايسين من التجمعات الجماعية وسيلةً لإضفاء الرهبة على المكان، فيوهمون السائق بأنّ أي مقاومةٍ ستُقابل برد فعلٍ جماعي، فيحكمون قبضتهم على الشارع، وكأنهم يظنون أنفسهم “أشدّ بأسًا وأشدّ تنكيلًا”، لكنهم في واقع الأمر محض فقاعاتٍ زائفة، تزول عند أول مواجهةٍ جادة.
– النتيجة الإجرامية (الأثر المترتب على سلوك السايس)
النتيجة الإجرامية هنا تتمثل في حالة الرعب والتخويف التي تصيب المجني عليه، وحرمانه من حرية التصرف في ماله وسيارته دون تهديد، مما يؤدي إلى: – إكراه السائق على دفع المال رغمًا عنه، وهو جوهر الجريمة. – تكدير الأمن والسكينة العامة، إذ يشعر المواطن أنه غير آمن حتى في حقه المشروع بالوقوف في الشارع. – الإضرار بالممتلكات الخاصة، حين يلجأ السايس إلى تخريب المركبات انتقامًا من الرافضين للدفع.
– علاقة السببية (الربط بين الفعل والنتيجة)
علاقة السببية هنا واضحة: لولا تهديد السايس واستعراضه للقوة، لما أُجبر السائق على الدفع، ولولا تصرفاته العدوانية، لما تكدّر الأمن العام، أو لحقت الأضرار بالمركبات.
2: الركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي)
لا تقوم جريمة البلطجة إلا إذا كان لدى الجاني نية إجرامية واضحة، أي أنه يعلم أن فعله غير قانوني، ومع ذلك يصرّ على ارتكابه لتحقيق منفعة غير مشروعة.
وهذا القصد يتجلى في:
– إدراك السايس أنه ليس موظفًا رسميًا، ومع ذلك يفرض إتاواتٍ دون سند قانوني.
– إرادته الواضحة في ترويع السائقين، واستغلال نفوذه على الطريق.
– تعمده إلحاق الأذى بالممتنعين عن الدفع، سواء بشكل مباشر (التهديد) أو غير مباشر (الإضرار بالمركبات).
ويكفي هنا أن يكون القصد الجنائي عامًا أو خاصًا، أي سواء كان السايس يقصد الترهيب بشكل عام، أو كان هدفه المباشر هو إجبار السائقين على الدفع، فكلاهما يؤدي إلى وقوع الجريمة.
سابعاً :العقوبة المقررة للسايس المخالف
بموجب المادة 375 مكرر، فإن السايس الذي يرتكب هذه الجرائم يواجه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وقد تزيد العقوبة وفقًا للظروف المشددة، مثل:
– إذا كان الفعل قد تم بواسطة أكثر من شخص (التجمهر والتواطؤ).
– إذا أدى التهديد إلى إصابة أو أذى جسدي لأحد السائقين.
– إذا ثبت تكرار الجريمة أو أن الجاني محترف في ممارسة البلطجة.
ثامناً :الخاتمة
إن ترك ظاهرة السايس المخالف دون ردع قانوني صارم يُشكل تهديدًا مباشرًا لهيبة الدولة وسيادة القانون، لأن السماح لهؤلاء بفرض إتاواتهم على الناس يعني التسليم بفكرة “السلطة الموازية” التي تخضع لمنطق القوة بدلًا من منطق القانون. وحيث إن الأصل في الفضاء العام أن يكون متاحًا للجميع دون قيود غير قانونية، فإن استمرار هذه الظاهرة يعني أن المجتمع بأسره يتحمل وطأة التقاعس في تطبيق القانون، مما يفرض على الجهات المختصة أن تُبادر إلى: – تشديد العقوبات على ممارسات السايسين غير القانونيين. – تكثيف الحملات الأمنية لضبط هؤلاء وردعهم. – توعية المواطنين بحقوقهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن هذه الجرائم دون خوف. إن المجتمع القائم على القانون هو مجتمع لا يخضع فيه الناس للابتزاز، ولا يكون فيه الخضوع فرضًا يُمليه الخوف، بل يكون الإنسان فيه حرًا، سيدًا في حقوقه، لا يملك أحد أن يسلبه ما ليس له به حق.
إنّ الشارع الذي تغيب فيه هيبة القانون، إنما هو غابةٌ مفتوحةٌ تنهشها الذئاب، حيث يصبح الحق مُجرّد سرابٍ، وتتحوّل الطرقات إلى حلبةٍ للفوضى يمسك بزمامها من يستأسد على الضعفاء بغير سلطان. فكيف يليق بدولةٍ ترعى العدل أن تسمح لمن لا يملك السلطة أن يُمارسها بالسوط والتهديد؟! وكيف يستقيم ميزان الحق إذا صار الشارع ميدانًا يُفرض فيه الخضوع بقوة التلويح بالعنف؟!
إنّ القانون ليس حبرًا على ورق، ولا مجرّد كلماتٍ جوفاء تُلقى في الفراغ، بل هو سيفٌ مشرعٌ في وجه العابثين، ورمحٌ يُدمي صدور من يظنّ أنّ التخويف والابتزاز صنعةٌ تُدرّ عليه المال الحرام. إنّ الدولة التي تتخاذل عن تطبيق القانون، تُمهّد الأرض لمن يحسب أنّ الصمت علامةُ ضعف، وتمنح السلطة لمن لم يُؤتَ من أسبابها شيئًا. فإذا أُريد للحق أن يَسُود، كان لزامًا أن يُسحق الباطل تحت أقدام القانون، قبل أن يتحوّل التهاون إلى رخصةٍ تجيز لكل مُتسلّطٍ أن يسوم الناس ذُلّ الجبروت.
وإذ كان القانون هو الضامن الوحيد لحفظ الحقوق، فإنّ غضّ الطرف عن هذه الظاهرة يُعدّ إقرارًا ضمنيًا بالفوضى، وفتحًا لثغرةٍ تتسع مع الأيام، حتى يصبح اقتلاعها أشبه بخلع شجرةٍ ضربت بجذورها في عمق المجتمع. فلا يجوز أن يُترك الشارع نهبًا لمن تسوّل له نفسه أن يُرهب الناس ويبتزّهم، بل ينبغي أن يُطبق عليه القانون بكل حزمٍ، ليُدرك أنّ الدولة قادرةٌ على قمع الاستغلال، تمامًا كما يُقمع الظلم إذا حان أوان القصاص.
وانطلاقًا من هذه الضرورة المُلحّة، وتأكيدًا على أنّ العدالة لا تنتظر، والحقوق لا تُستجدى بل تُنتزع بقوة القانون، فقد قدّمنا مشروع قانونٍ متكاملٍ يُجرّم هذه الممارسات بكل صرامة، ويُغلّظ العقوبات على كل من تُسول له نفسه أن يتلاعب بحقوق المواطنين أو يفرض إتاواته بغير سندٍ مشروع، ليكون هذا المشروع خطوةً جادةً نحو استعادة الشارع من قبضة من يظنون أنّهم فوق القانون، وإرساءً لمبدأ أنّ الأمن في المجتمع ليس منحةً تُمنح، بل حقٌ أصيلٌ لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة.
وإذ كان القانون قد حسم هذه المسألة نظريًا، فإنّ نجاح المواجهة العملية يقتضي اتخاذ إجراءاتٍ صارمة، منها: 1. تشديد الرقابة الأمنية: فلا بد من فرض رقابةٍ مكثفة على الشوارع، وإجراء حملاتٍ لضبط السايسين غير المرخصين، واتخاذ إجراءاتٍ رادعة ضدهم. 2. تطبيق العقوبات دون تهاون: إذ إنّ النصوص القانونية القائمة كفيلةٌ بردع هذه الظاهرة، متى ما تمّ تطبيقها بحزم، دون أن يُتاح للمخالفين أي ثغرةٍ للإفلات من العقاب. 3. إيجاد بدائل رسمية للركن: من خلال توسيع نطاق المواقف الرسمية، وإطلاق نظم الدفع الإلكتروني، بحيث يُلغى التعامل المباشر مع الأفراد غير المرخصين. 4. تعزيز وعي المواطنين من خلال حملاتٍ توعوية تُعرّف السائقين بحقوقهم، وتحثهم على الإبلاغ عن أي محاولة استغلالٍ يتعرضون لها.
النتائج والتوصيات
مشروع قانون لتجريم ظاهرة “السّايس” غير المرخص واستغلال الفضاء العام بغير سندٍ قانوني
المذكرة الإيضاحية
لما كانت ظاهرة “السّايس” غير المرخص قد تفاقمت في الآونة الأخيرة، حتى أضحت تهديدًا مباشرًا للنظام العام، ومساسًا صريحًا بحقوق المواطنين في الانتفاع بالمجال العام دون ترهيبٍ أو ابتزاز، وكان من شأن هذه الممارسات أن تؤدي إلى إرساء سلطةٍ موازية تفرض نفسها على الشوارع والميادين دون أي سندٍ قانوني، فقد بات لزامًا سن تشريعٍ خاص يواجه هذه الظاهرة، ويضع لها حدًا رادعًا، يُعزز من هيبة الدولة، ويكفل احترام القانون.
وبناءً على ذلك، فإن هذا المشروع يهدف إلى:
-
تجريم ظاهرة السّايس غير المرخص، باعتبارها تعديًا صارخًا على الحقوق العامة، واستغلالًا غير مشروعٍ للمرافق العامة.
-
فرض عقوباتٍ مغلظة على كل من يمارس مهنة السّايس دون ترخيصٍ، أو يفرض إتاواتٍ ورسومًا بغير سندٍ قانوني.
-
إدراج عقوباتٍ تكميلية وتدابير احترازية لضمان عدم عودة المخالفين لممارسة هذه الأفعال، مع مصادرة أي أدواتٍ تُستخدم في ارتكاب الجريمة.
مواد مشروع القانون
الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
المادة (1) – تعريف الظاهرة
يقصد بـ”ظاهرة السّايس غير المرخص” في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخصٍ يباشر تنظيم وقوف المركبات أو فرض رسومٍ أو إتاواتٍ على أصحاب المركبات في الطرق أو الساحات العامة أو الخاصة دون الحصول على ترخيصٍ مسبق من الجهة المختصة، سواء أكان ذلك بمقابلٍ أم دون مقابل، وسواء أكان بصفةٍ فرديةٍ أم جماعيةٍ منظمة.
المادة (2) – نطاق التجريم
يُعد مرتكبًا لجريمة “السّايس غير المرخص” كل من:
-
تولى بنفسه أو بواسطة الغير استغلال أماكن وقوف السيارات أو تنظيمها دون ترخيصٍ من السلطة المختصة.
-
فرض رسومٍ أو إتاواتٍ مالية على أصحاب المركبات نظير السماح لهم بالركن في الأماكن العامة أو الخاصة دون تفويضٍ قانوني بذلك.
-
استعرض القوة أو مارس التهديد أو العنف أو أية وسيلةٍ غير مشروعة لإجبار السائقين على دفع مقابلٍ مالي.
-
قام بحجز أماكن عامة أو استغلالها لغرضٍ شخصي أو تجاري دون وجه حق.
الفصل الثاني: العقوبات الأصلية
المادة (3) – العقوبة في صورتها البسيطة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (4) – العقوبة المشددة
تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، إذا اقترنت الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) بأحد الظروف التالية:
-
إذا ارتُكبت الجريمة باستخدام القوة أو التهديد أو الترويع.
-
إذا كان مرتكب الجريمة من أصحاب السوابق في أعمال البلطجة أو فرض السيطرة غير المشروعة.
-
إذا نتج عن الفعل إتلاف ممتلكات الغير عمدًا، أو الاعتداء بالضرب على صاحب المركبة.
-
إذا كان الجاني يعمل ضمن تشكيلٍ عصابي، أو بالاتفاق مع آخرين لتنفيذ الجريمة.
الفصل الثالث: العقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية
المادة (5) – العقوبات التكميلية
يحكم، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، بتوقيع العقوبات التكميلية الآتية:
-
المصادرة: يتم الحكم بمصادرة أي أدواتٍ أو معداتٍ استُخدمت في ارتكاب الجريمة، بما في ذلك الأقماع، والحواجز، والمفاتيح، وأي وسائل أخرى استخدمت في فرض السيطرة على أماكن الركن.
-
الإدراج في سجل المنع من مزاولة النشاط: يحظر على المحكوم عليه ممارسة أي أعمالٍ تتعلق بتنظيم المركبات، أو أي نشاطٍ مشابهٍ لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.
-
الإغلاق الإداري للمكان: في حالة ثبوت استخدام محلٍ أو مكانٍ محدد لممارسة النشاط غير المشروع، يجوز للجهة المختصة غلقه إداريًا لمدة لا تقل عن سنة، مع وضع لافتة تفيد بمخالفة النشاط للقانون.
المادة (6) – التدابير الاحترازية
في حال العود لارتكاب الجريمة، يجوز للمحكمة أن تقضي بأحد التدابير الاحترازية الآتية:
-
الإلزام بأداء خدمةٍ عامة: كالمشاركة في برامج التوعية المرورية، أو تنظيف المرافق العامة، كعقوبةٍ بديلةٍ تهدف إلى إصلاح السلوك.
-
الوضع تحت المراقبة الشرطية: لفترةٍ لا تقل عن سنتين، لضمان عدم تكرار الجريمة.
-
حظر التواجد في أماكن معينة: يجوز للمحكمة أن تقضي بحظر المحكوم عليه من التواجد في أماكن الركن العامة لمدة تحددها وفقًا لخطورة الجريمة المرتكبة.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
المادة (7) – اختصاص القضاء
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتُحال الدعاوى إلى المحاكم الجنائية المختصة للفصل فيها على وجه الاستعجال.
المادة (8) – التنفيذ والتطبيق
تصدر السلطة التنفيذية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (9) – الإلغاء
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، أينما ورد في أي تشريعٍ آخر.
المادة (10) – العمل بالقانون
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره.