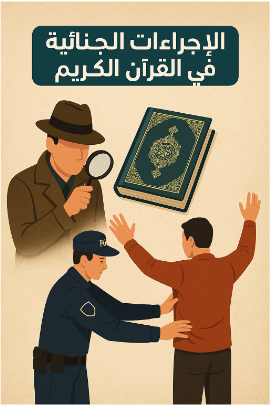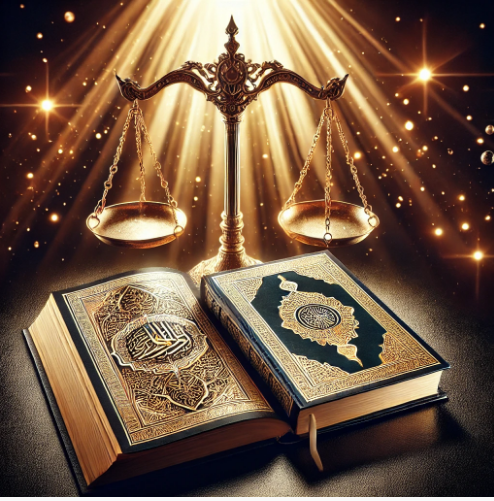
مقدمة
لا غرو أن مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” يُعدّ أحد أقدس المبادئ التي تحكم العدالة الجنائية، إذ إنه السياج الحصين الذي يحول دون تغول السلطة على الأفراد، والدرع الواقي الذي يتكئ عليه العدل في مجابهة الطغيان القضائي، وضمانة الحق في صون الكرامة الإنسانية من أن تطالها يد الجور بلا دليل قاطع. ولئن كان هذا المبدأ اليوم من ركائز الأنظمة القانونية الحديثة، فإنه ضارب بجذوره في صميم التشريع الإسلامي، حيث قرره القرآن الكريم في نصوص محكمة، تُعلي من شأن العدل، وتحظر الظلم بكل صوره، جاعلة من اليقين قاضيًا لا يدفعه الهوى، ومن الشبهة عائقًا لا ينهدم إلا ببرهان لا يرقى إليه الريبة.
وحيث إن العدالة لا تقوم إلا على دعائم متينة من النزاهة والإنصاف، فقد اقتضت حكمة الشريعة أن لا يُساق المرء إلى العقاب إلا عن بيّنة جلية، كيف لا، والقرآن قد جعل إقامة الحجة مقدمةً لازمةً قبل أي اتهام، فقال تعالى: “قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ” (البقرة: 111). بل إنه لم يكتفِ بمجرد تقرير البراءة الأصلية للإنسان، وإنما أرسى لها ضمانات راسخة، تحول دون أي تجاوز أو تعسف في تطبيقها، حتى غدت هذه القاعدة “كالصخرة الصماء في مجرى العدالة، لا تجرفها الادعاءات الواهية، ولا تهزها الظنون العارية عن الدليل”.
وفي حين تسارعت النظم القانونية إلى استلهام هذا المبدأ وإدراجه في دساتيرها، لم يكن ذلك إلا صدى متأخرًا لما أقره القرآن الكريم قبل قرون خلت، حيث جعله قاعدة “كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء”، لا تنال منها الأهواء، ولا يعتريها التحريف، وإنما تظل ميزانًا قائمًا في كل زمان ومكان، إذ كيف يُدفع امرؤ إلى العقاب، والعدل يقتضي أن يكون الاتهام مقرونًا بالحجة، واليقين قاضيًا لا يخضع للظنون؟
أولًا: الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس
لا غرو أن مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” هو سياج العدالة المنيع، وقلعة الحق الراسخة، التي تتحطم على أسوارها رياح الظلم وأعاصير الجور. فهو القاعدة التي تقوم عليها صروح القوانين الحديثة، لكنه في حقيقته مبدأ موغل في القدم، أرساه القرآن الكريم في نصوص جلية تُعلي من شأن العدل، وتحذر من التسرع في إطلاق الأحكام بغير بينة. فالاتهام بلا دليل كمن يخبط في الظلمات، تتقاذفه الأوهام، وتحيط به العثرات، فلا يهتدي إلى سبيل، وقد حسم الله الأمر بقوله: “وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ” (الإسراء: 36)، إذ جعل مجرد اتباع الظن كمن يسير خلف سراب يظنه ماءً، حتى إذا جاءه لم يجده إلا وهْمًا خادعًا.
ثم جاء النص القرآني ليؤكد أن الإدانة لا تكون إلا ببينة قاطعة، فقال: “قُلْ هَاتُوا بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ” (البقرة: 111)، فكان الاتهام بغير دليل كمن يبني قصرًا على الرمال، سرعان ما تبدده رياح الحق فلا يبقى له أثر. ولئن كانت القوانين الحديثة قد أحاطت هذا المبدأ بضمانات إجرائية، فإن التشريع الإلهي قد سبَقها فجعل العدالة ميزانًا لا يميل، لا تهزه شبهة، ولا تنال منه الأهواء، ولا تخدعه المظاهر، بل جعل اليقين شرطًا لازمًا قبل المساس بحريات الأفراد، فالإدانة بلا برهان كشجرةٍ بلا جذور، مهما بدت أوراقها خضراء، فإن ريح الحق تقتلعها من أساسها.وهكذا، جاء القرآن الكريم ليكون نبراس العدالة الذي لا ينطفئ نوره، وميزان الحق الذي لا يختل، وصوت المظلوم الذي لا يخفت مهما علا صخب الباطل.
ثانيًا: التشدد في الإثبات ضمانًا لبراءة المتهم
ومن أعظم ما أرساه القرآن الكريم في ميزان العدالة أنه ألقى عبء الإثبات على من يدعي الجريمة، ولم يُحمِّل المتهم عناء إثبات براءته، فجعل الادعاء بلا بينة كسرابٍ يحسبه الظمآن ماءً، حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الجليل بقوله: “البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر”، ليقطع بذلك الطريق أمام الظلم، فلا يُساق أحد إلى المحاكمة لمجرد شبهة أو ظن.
وقد جاء القرآن الكريم ليجسد هذا المبدأ بوضوح في قوله تعالى: “وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًۭا” (النور: 4)، وهنا يبلغ القرآن غاية الإنصاف، فلا يكتفي بعدم الأخذ بالاتهام بلا دليل، بل يُنزِل العقاب على من يجرؤ على اتهام غيره دون بينة، فيكون هو الجاني لا المجني عليه، ويصبح في نظر العدالة كمن يحفر بئرًا ليسقط فيه، أو كمن يشعل نارًا لتحرقه قبل غيره.
وهذا المبدأ ليس مجرد نص ديني، بل هو ركيزة تشريعية راسخة، تتناغم مع الأنظمة القانونية الحديثة، التي لا تعترف بالاتهام المرسل، ولا تقيم وزنًا للادعاء الذي يخلو من حجج دامغة، بل تُعاقب من يُلقي بالاتهامات جزافًا، حمايةً للمجتمع من الفوضى، وللعدالة من العبث.
ثالثًا: الشك يُفسر لصالح المتهم
إن القاعدة الذهبية “الشك يُفسر لصالح المتهم”ليست مجرد مبدأ قانوني وليد العصر الحديث، بل هي ركن ركين في ميزان العدالة الإلهية، أرساه القرآن الكريم كالطود الشامخ الذي لا تهزه العواصف، وجعله حصنًا منيعًا يحول دون أن يُساق الأبرياء إلى ساحات العقاب بغير بينة. فجعل اليقين كالشمس في رابعة النهار، لا تُحجب بغيم الظنون، ولا تعكر صفوه ظلال الريبة، وجعل البراءة نهرًا رقراقًا لا يعكره غبار التهم الباطلة، حتى يثبت بالدليل القاطع أنه قد تكدّر.
وفي قصة يوسف عليه السلام، تتجلى هذه القاعدة بأبهى صورها، حين اتُّهم ظلمًا بمراودة امرأة العزيز، لكن القرآن لم يترك مصيره معلقًا بخيوط ادعاء واهنة، كبيت العنكبوت الذي ينهار عند أول لمسة، بل وضع قاعدة جلية، بأن الادعاء المجرد كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا. فجاء قوله تعالى:
“قَالَ هِيَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌۭ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍۢ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن ٱلصَّٰدِقِينَ”** (يوسف: 26-27).
فهنا، لم يُقبل الادعاء كالرياح العاتية التي تعصف بالناس دون أن يُنظر في حقيقتها، بل كان لا بد من دليل مادي يُفصل بين الصدق والبهتان، كما يفصل السيف بين المفترقين. فجُعل القميص لسانًا ناطقًا بالحق، وشاهدًا صامتًا أبلغ من ألف قول، يقطع الشك باليقين، ويُثبت أن المتهم بريء حتى يُثبت العكس.
وهذا التشديد في الإثبات لم يكن خاصًا بقضية يوسف، بل هو قاعدة أصيلة في الشريعة، جسّدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: “البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر”، وكأن الادعاء بلا دليل ظلٌّ زائل لا تثبته شمس الحقيقة، وصوتٌ واهن لا يعلو على صدى اليقين.
ومن أعظم ما قرره الإسلام في هذا السياق قاعدة “الحدود تُدرأ بالشبهات”، فجعل الشبهة سورًا حصينًا يمنع تنفيذ العقوبة إلا إذا كان الحق أوضح من الشمس، وأسطع من ضياء القمر ليلة البدر. فكما لا يُبنى البيت على الرمال، ولا يُحكم على الناس بمجرد الظنون، كذلك لا تُقام العقوبات إلا إذا كان الدليل صلبًا كالصخرة التي لا تتفتت، وواضحًا كالنور الذي لا تُخفيه الظلمات.
وهكذا، نجد أن القرآن الكريم قد سبق الفقه الجنائي الحديث بقرون طويلة في إرساء هذه المبادئ العظيمة، فجعل العدالة لا تخضع لأهواء البشر، ولا تُحكمها العاطفة العمياء، بل تقوم على يقين كالجبال الرواسي، لا يتزلزل، ولا ينهار.
رابعًا: تجريم إدانة الأبرياء ظلمًا
لقد شدد القرآن الكريم على خطورة إدانة الأبرياء ظلمًا، وجعل ذلك من أعظم صور الفساد الذي ينخر في بنيان المجتمعات كما تنخر الأرضة في الخشب، حتى يتهالك بنيانه وينهار. فالاتهام الباطل كريحٍ عاتية تعصف بأمن الأفراد، وكظلام دامس يحجب نور الحقيقة، فلا يبقى إلا الظلم معربدًا في الآفاق. وقد جاء التحذير الإلهي شديدًا في قوله تعالى:
“وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًۭا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًۭٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَٰنًۭا وَإِثْمًۭا مُّبِينًۭا” (النساء: 112).
فهذه الآية تصور مدى بشاعة الظلم حين يُقلب الحق باطلًا، ويُلقى بالجرائم على من لم يقترفها، وكأن الظالم يحمل على عاتقه صخرة من البهتان، كلما خطا بها خطوة زادته انحدارًا نحو الهاوية. ولا غرو أن هذا المنهج القرآني يتماهى مع القواعد الجنائية الحديثة، التي تعتبر أن إدانة شخص بناءً على أدلة ضعيفة أو مفتعلة، كمن يحاول بناء صرح شاهق على الرمال، فلا يلبث أن ينهار تحت وطأة الحقائق.
فالعدالة لا تستقيم إلا إذا بُنيت على أساسٍ متين كالجبل، لا تهزه العواصف، ولا تميل به الأهواء، وإلا أصبحت ساحات القضاء مرتعًا للظلم، وموطنًا للبهتان، حيث يُجرّم البريء، ويُبرأ المجرم، وتختلط الأصوات حتى لا يُعرف للحق وجهٌ ولا طريق.