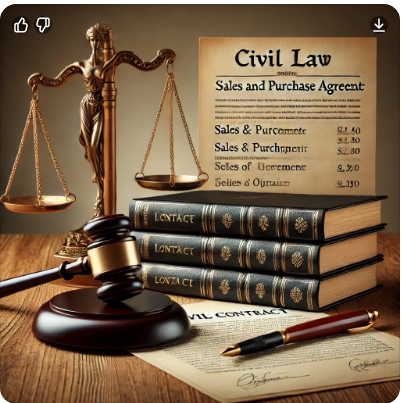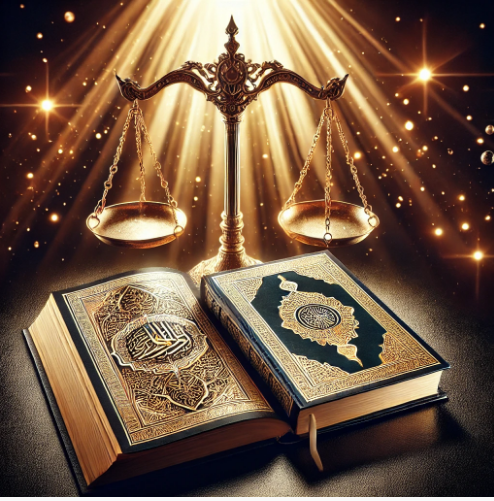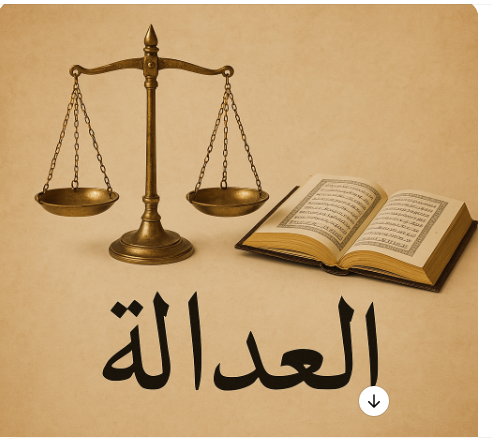مقدمة
لا جرم أن القضاء المدني في الإسلام يستند إلى أسس راسخة، جعلت منه ميزانًا للحق، وركيزة للعدل، وسياجًا يحفظ الحقوق ويصون المعاملات بين الناس. ولم يكن هذا القضاء قائمًا على الأهواء البشرية أو المصالح الضيقة، بل كان مستمدًا من شريعة محكمة، أحكمت أصول التقاضي، ورسّخت مبادئ التوثيق والإثبات، وأقامت العدل على قواعد متينة، تجمع بين الإنصاف والدقة، وبين الرحمة والحزم. وإذا كان التشريع الحديث قد أرسى قواعد العقود، وأسس الإثبات، وضوابط المعاملات المالية، فإن القرآن الكريم قد سبق إلى بيان هذه الأصول بأسلوب بالغ الإحكام، يعكس دقة التشريع الإلهي وكمال منظومته. ولما كانت العقود هي الأساس الذي تُبنى عليه التعاملات بين الناس، فقد وضع القرآن الكريم قاعدته الكبرى التي لا استقرار للمعاملات بدونها، فقال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” (المائدة: 1). وهذه الآية تُعد أصلًا عامًا شاملًا، يلزم الناس بالوفاء بكل ما يعاهدون عليه، من بيع، أو شراء، أو زواج، أو إجارة، أو غيرها من العقود التي تضبط التعاملات بين الأفراد والمجتمعات. فكما أن البناء لا يقوم إلا على أعمدة قوية، فكذلك المعاملات لا تستقيم إلا بالالتزام بالعقود، ومن ينقض عهده أو يخلّ بشروطه، فكأنما يهدم بنيانًا راسخًا، فينهار على رأسه. وحيث إن العقود لا تُقام على مجرد القول المجرد، بل تحتاج إلى إثبات يُظهر حقيقتها ويمنع النزاع حولها، فقد وضع القرآن الكريم أصل الإثبات والتوثيق في المعاملات بقوله: “وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ” (البقرة: 282). فهذه القاعدة التشريعية تضع الإثبات كشرط رئيسي في صحة التعاملات، فلا يكفي أن يُبرم شخص عقدًا، بل لا بد من توثيقه وإقامة الدليل عليه، لئلا يكون عرضة للإنكار أو التلاعب. وكما أن السفينة لا تمخر عباب البحر إلا إذا كانت مؤمّنة بحبال وثيقة، فكذلك العقود لا يُعتد بها إلا إذا كانت مؤيَّدة بالإثبات والشهادة. ولأن المعاملات المالية هي عصب الحياة الاقتصادية، فقد قرر القرآن الكريم أن الأساس الذي يُبنى عليه كل تعامل مالي هو المشروعية والرضا، فقال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ” (النساء: 29). فالتجارة ليست مجرد تبادل سلع أو أموال، بل هي عقد يقوم على التراضي، فلا يُجبر أحد على بيع ما لا يريد، ولا يُشترى شيء إلا بموافقة حرة. وكما أن الأرض لا تُنبت زرعًا إلا إذا رُويت بماء نقي، فكذلك المعاملات المالية لا تثمر إلا إذا كانت قائمة على الرضا والعدل. وإذا كان الفرد قد يعقد اتفاقاته المالية مع غيره، فإن الشراكة هي صورة أوسع للعلاقات التجارية، وهي أكثر تعقيدًا من البيع البسيط، إذ إنها تقوم على تقاسم الأموال والأرباح والخسائر. وهنا يحذر القرآن الكريم من الظلم الذي قد يقع في الشراكات، فيقول تعالى: “وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ” (ص: 24). فالخلطاء هم الشركاء، وكثير منهم قد يجنح إلى الظلم والاعتداء على حقوق غيره، ولا يسلم من ذلك إلا أصحاب الإيمان الصادق والتقوى. وكما أن الماء العذب قد يختلط بالماء المالح فيفقد عذوبته، فكذلك الشراكة إذا دخل فيها الظلم، فقدت معناها وتحولت إلى أداة للنهب والاستغلال. وهكذا يتضح أن القضاء المدني في الإسلام لم يكن مجرد اجتهاد بشري، بل هو تشريع إلهي وضع لكل معاملة ميزانها، ولكل عقد ضمانه، ولكل شراكة ضابطها، حتى يستقيم العدل بين الناس. ومن هنا، فإن أي نظام قضائي لا يأخذ بهذه الأصول، فهو كبيتٍ بُنِي على شفا جرف هار، سرعان ما ينهار ويهوي بأهله إلى مهاوي الفساد والظلم، إذ لا استقرار للمجتمعات إلا حين يكون العدل هو الميزان، والوفاء هو القاعدة، والحق هو الغاية التي تُبنى عليها الأحكام.
١- النبي داوود: نموذج القاضي العادل في المنازعات المدنية
ولما كان القضاء في جوهره ميزانًا للعدل بين الناس، فقد أورد القرآن الكريم قصة النبي داوود عليه السلام، الذي ابتُلي بمسؤولية الفصل في النزاعات، فجاءه رجلان يختصمان، فقال أحدهما: “إِنَّ هَٰذَآ أَخِى لَهُۥ تِسْعٌۭ وَتِسْعُونَ نَعْجَةًۭ وَلِىَ نَعْجَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِى فِى ٱلْخِطَابِ” (ص: 23). وهذه الصورة القرآنية تُجسّد أسمى صور المنازعات المدنية، حيث تتعلق بحق الملكية واستغلال النفوذ. فالشاكي يُقرّ بأن خصمه ليس مجرد مستحوذ، بل استخدم أسلوبًا قهريًا في انتزاع الحق، إذ قال: “وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ”، أي غلبني بحجته وقوّة بيانه، مما يُبرز أهمية الإنصاف في القضاء، إذ ليس الأقوى بيانًا هو الأحق، ولا الأكثر نفوذًا هو الأجدر بالحكم. وقد قضى داوود عليه السلام لصالح المظلوم، لكنه أدرك بعد ذلك أن العدل لا يُبنى على ظاهر الأقوال دون تمحيص، فاستغفر ربه، كما قال تعالى: “وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّـٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًۭا وَأَنَابَ” (ص: 24). وهذا يؤكد قاعدة أصيلة في القضاء المدني، وهي ضرورة سماع الطرفين بتأنٍّ، وإقامة العدل بناءً على بينة راسخة لا على مظاهر خادعة، فإن القاضي إنما يحكم بالحقائق لا بالأقوال، وبالعدل لا بالهوى، وإلا كان كمن يقبض على السراب، أو يزن الريح بميزان الوهم.
٢- النبي سليمان: عبقرية القضاء المدني في حل النزاعات
تجلّت في القرآن الكريم عبقرية القضاء المدني من خلال قصة النزاع بين امرأتين على طفل، حيث ادّعت كلٌّ منهما أنه ابنها. ولما احتكمتا إلى النبي داوود عليه السلام، قَضى بالطفل لمن بدا أنها أحق به، إلا أن النبي سليمان عليه السلام، بذكائه الفذّ، أعاد النظر في القضية، واستنبط حكمًا بالغ الحكمة، فقال: “ٱقْطَعُوهُ بِنِصْفَيْنِ” (راجع سورة النمل والسياق التفسيري للآية). فما إن سمعت الأم الحقيقية هذا الحكم حتى فاض قلبها رحمة، فبكت ورفضت أن يُقسَم طفلها، مفضّلة أن يعيش ولو كان في حضن الأخرى، فعلم سليمان عليه السلام أنها الأم الصادقة، وأعاد الطفل إليها. وهذا الحكم القرآني يُبرز أهمية ذكاء القاضي المدني في كشف الحقائق عبر الاستنباط، لا من خلال الأدلة الظاهرة فحسب، إذ إن العدل لا يكون مجرد تَحَصُّلٍ على الأدلة، بل يمتد إلى الغوص في أعماق النفوس، واستقراء المواقف، واستجلاء الحق عبر الفِطنة والبصيرة، كما قال الله تعالى: “وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ” (ص: 20)، وهي صفةٌ آتاه الله إياها، فكان بها قادرًا على إحقاق الحق بأسلوبٍ لا تخطئه الفطرة السليمة.
٣- النبي محمد ﷺ: المثل الأعلى للقضاء المدني
لقد كان النبي محمد ﷺ النموذج الأمثل للقاضي العادل، فلم يكن حكمه بين الناس مجرد اجتهادات آنية، بل كان مؤسَّسًا على مبادئ قانونية متينة، أصبحت فيما بعد أساسًا للأنظمة القضائية المدنية في شتى العصور. فقد أرسى ﷺ قواعد الإثبات، ونظّم العقود والتصرفات المالية، ووضع أصولًا راسخة لحماية الحقوق الفردية والجماعية. وفيما يلي نماذج من قضائه المدني، تُبرهن على عبقريته التشريعية ورسوخ مبادئه في إقامة العدل. ١- تنظيم العقود وإثباتها: بيع السَّلَم نموذجًا جاء رجل إلى النبي ﷺ يسأله عن البيع بالسَّلَم، وهو عقد يقوم على دفع الثمن مقدمًا مقابل تسليم المبيع لاحقًا، فأقرّه النبي ﷺ، لكنه وضع له ضوابط دقيقة تحول دون الجهالة أو الغرر، فقال: “من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم”(رواه البخاري ومسلم). وهذا الحكم يُعَدّ قاعدة أساسية في العقود المدنية الحديثة، حيث لا يصحّ الالتزام إلا إذا كان محلّه محددًا تحديدًا دقيقًا، وهو ذات المبدأ الذي تأخذ به القوانين اليوم في باب العقود المسماة، كعقود البيع والإيجار والمقاولة. ٢- حماية حقوق الشريك في الملكية: تقرير حق الشفعة من الأحكام المدنية التي قررها النبي ﷺ، قاعدة حق الشفعة، التي تحمي الشريك في العقار من دخول شريك أجنبي قد يسبب له ضررًا. فقد قال ﷺ: “الشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة” (رواه البخاري). وهذا الحكم يتوافق مع مبدأ استقرار التعاملات العقارية، حيث يمنح الشريك فرصة الاحتفاظ بحقه قبل أن تتغير طبيعة الملكية. ٣- الحجر على السفيه: صون الحقوق المالية ثبت أن النبي ﷺ أقرّ الحجر على المبذّر الذي لا يُحسن التصرف في ماله، ومن ذلك ما جاء في الحديث الشريف: “من باع عَبدًا له مال، فمالُه للبائع، إلا أن يُشترط المبتاع”(رواه البخاري). وهذا يؤصل مبدأ الحجر في القانون المدني، وهو منع التصرفات المالية الضارة، وهو ذات المبدأ الذي تطبقه المحاكم المدنية عند فرض الوصاية على القُصّر أو المحجور عليهم لسفههم أو ضعف إدراكهم. ٤- إثبات الحقوق وحيازة المال الضائع: قضية اللقطة جاء رجل إلى النبي ﷺ يسأله عن المال الذي يجده في الطريق (اللقطة)، فقال له النبي ﷺ: “اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها” (متفق عليه). وهذا الحكم يضع قواعد واضحة لحيازة المال الضائع، حيث يُلزم واجده بالإعلان عنه مدةً معينة قبل أن يصبح من حقه، وهو ذات المبدأ الذي تأخذ به الأنظمة الحديثة تحت مسمى “الاستيلاء الشرعي”. ٥- الفصل في النزاعات العقارية: قاعدة الإثبات والبينة جاء رجلان إلى النبي ﷺ يتنازعان على أرض، فقال لهما: “البينة على المدعي، واليمين على من أنكر” (رواه الترمذي وصححه الألباني). وهذا الحديث يُعَدّ من أعظم القواعد القانونية في الإثبات، حيث يتحمل المدعي عبء تقديم الأدلة لإثبات دعواه، فإن عجز، كان للمدعى عليه أن ينفيها بيمين قاطعة، وهو ما تقوم عليه أنظمة القضاء المدني المعاصر. ٦- النزاع حول الطفل: عبقرية النبي سليمان في الإثبات من أروع القضايا المدنية التي تناولها القرآن، قصة امرأتين تنازعتا على طفل، فاحتكمتا إلى النبي داوود، ثم إلى ابنه سليمان عليهما السلام، فحكم سليمان بحكمٍ عبقري حين قال: “ٱقْطَعُوهُ بِنِصْفَيْنِ” (راجع سورة النمل والسياق التفسيري للآية). فبكت الأم الحقيقية ورفضت، فعلم سليمان أنها الأم الصادقة، وأعاد الطفل إليها. وهذا يُجسّد ذكاء القاضي المدني في كشف الحقائق بالاستنباط، وليس فقط من خلال الأدلة المباشرة. ### **٧- النبي محمد ﷺ وتحذيره من التلاعب بالقضاءأرسى النبي ﷺ مبدأً بالغ الأهمية في القضاء المدني، وهو أن القاضي يحكم بالأدلة الظاهرة، لكنه غير مسؤول عن الباطن، فقال ﷺ: “إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار” (متفق عليه). وهذا الحديث يرسّخ أن القاضي المدني لا يحكم بالهوى، بل بالأدلة والقرائن، وأنه قد يُخدع بالمرافعات البارعة، لكنه غير مسؤول أمام الله إلا عمّا ظهر له من البينات. النبي محمد ﷺ واضع أرقى أسس القضاء المدني إن القواعد التي أرساها النبي محمد ﷺ لم تكن مجرد أحكام دينية، بل كانت نواةً لنظام قضائي متكامل، لا يزال أثره ممتدًا إلى يومنا هذا. فقد وضع الضوابط المحكمة للعقود، ونظّم قواعد الإثبات، وحمى الحقوق المالية، ورسّخ مبادئ العدالة في تسوية النزاعات المدنية. ولئن كانت الأنظمة القضائية الحديثة تزهو بمبادئها، فإنها لا تخرج عن تلك القواعد الرصينة التي سنّها النبي الكريم ﷺ، ليكون بذلك النموذج الأسمى للحاكم العادل والقاضي الحكيم الذي لم ينطق إلا بالحق، ولم يحكم إلا بالعدل. وهكذا، تبقى سيرته ﷺ أعظم مرجع لمن أراد أن يقيم العدل، ويؤسس لقضاء مدني يقوم على الحق، ويصون الحقوق، ويحفظ كرامة الإنسان.
٤- ضوابط القضاء المدني في القرآن الكريم
لطالما كان القضاء المدني ركيزة أساسية في تحقيق العدالة بين الناس إذ يُعنى بالفصل في المنازعات الحقوقية سواء تعلّقت بالعقود أو الملكية أو الالتزامات المالية أو غيرها من الحقوق الخاصة وإذا تأملنا القرآن الكريم وجدنا أنه أرسى دعائم القضاء العادل وبيّن صفات القاضي وأسس الحكم الصحيح بل قدّم نماذج تاريخية لقضاة مارسوا الحكم بين الناس بحكمة وعدل
حدد القرآن الكريم شروطًا صارمة للقاضي من أهمها العدل والنزاهة قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل النساء وهذا يضع قاعدة ذهبية للقاضي المدني وهي الحكم وفقًا للعدل لا وفقًا لمصالح شخصية أو ضغوطات خارجية كما أكد القرآن ضرورة الاستماع إلى الأطراف كافة دون تحيّز فقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى المائدة فحتى لو كان هناك عداء بين القاضي وأحد الخصوم فإن العدل مُقدَّم على الأهواء وكذلك يجب أن يكون الاحتكام إلى القواعد الشرعية والقانونية قال تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله المائدة أي أن القاضي المدني لا يحكم اعتباطًا بل يستند إلى أصول تشريعية واضحة
جاء في القرآن الكريم أن النبي داوود عليه السلام تولّى مهمة القضاء بين الناس وابتلاه الله بقضية مدنية تتعلّق بحق الملكية إذ جاءه رجلان يختصمان فقال أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزّني في الخطاب ص فقضى داوود لصالح المظلوم ثم أدرك أهمية التثبّت وسماع الطرفين جيدًا قبل إصدار الحكم وهذا يُرسّخ قاعدة جوهرية في القضاء المدني وهي ضرورة استيفاء البينات والحجج قبل الفصل في النزاع
من أبرز القضايا المدنية التي جاء بها القرآن قضية النزاع حول الطفل بين امرأتين حيث ادّعت كلٌّ منهما أنه ابنها فاحتكمتا إلى النبي داوود أولًا ثم إلى النبي سليمان عليه السلام فحكم بحكمٍ عبقري حين قال اقطعوه بنصفين فبكت الأم الحقيقية ورفضت فعرف سليمان أنها الأم الصادقة وأعاد الطفل إليها وهنا يظهر ذكاء القاضي المدني في كشف الحقائق من خلال الاستنباط وليس فقط من خلال الأدلة المباشرة
كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم القاضي الأول في الدولة الإسلامية وكان يفصل بين الناس وفقًا لمعيار العدل وقال في حديث صحيح إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار وهذا يرسّخ مبدأ أن القاضي المدني لا يحكم بالهوى بل بالأدلة وأنه قد يُخطئ إن احتال عليه الخصوم لكنه غير مسؤول عن باطن الأمور بل عن تطبيق القانون بعدالة ونزاهة
شهد القضاء المدني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عدة قضايا كان لها أثر في بناء المنظومة القضائية الإسلامية ففي إحدى القضايا جاء رجل إلى النبي يطالِب آخر بدين عليه فأنكر المدين فقال النبي البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهنا وضع النبي قاعدة أساسية في القضاء المدني وهي أن عبء الإثبات يقع على المدّعي وأن إنكار المدّعى عليه يُقبل إذا حلف اليمين كما حرص النبي على توثيق العقود فقال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وهو مبدأ أساسي في العقود المدنية حيث يحق لكلا الطرفين العدول عن العقد قبل التفرق مما يعكس أهمية الرضا التام قبل إتمام الالتزام التعاقدي وأيضًا أتى رجلان إلى النبي يختصمان في أرض فقال لهما إذا اختلفتم في الأرض فاجعلوها بينكم بالسوية أو قرعة وهنا يظهر مبدأ التحكيم العادل وإيجاد حلول ودية في النزاعات العقارية
لا غرو أن القضاء المدني ليس مجرد نظام حديث بل هو مبدأ راسخ في التشريع الإلهي حيث تجسّد في شخصيات قرآنية اضطلعت بمهمة الدفاع عن المظلوم والادعاء ضد الجناة وإقامة الحجة وجمع الأدلة والتحقيق النزيه ولئن كانت النظم القانونية المعاصرة تعتمد على قواعد وضعية فإن أصولها الحقيقية تستند إلى المبادئ العادلة التي أرسى القرآن الكريم دعائمها والتي تؤكد أن لا اتهام دون دليل ولا إدانة دون بيّنة ولا عقوبة دون عدل وأن القاضي لا بد أن يتحلى بالحكمة والفطنة والحرص على تحقيق المساواة بين الناس دون ميل أو تحيّز.
٥- القضاء المدني بين القرآن والقوانين الحديثة
لا غرو أن القضاء المدني يعدّ من أرقى التشريعات التي تضمن للناس حقوقهم، وتصون مصالحهم، وتضبط معاملاتهم وفق ميزان العدل والقسطاس المستقيم؛ إذ كيف يستقيم أمر المجتمعات إن لم يكن فيها ميزان قويم، يرفع الظالم وينصف المظلوم؟ ولئن كان التشريع الحديث قد أرسى مبادئ التقاضي وأسس المحاكمات وفق ضوابط دقيقة، فإن القرآن الكريم سبق إلى وضع أصول القضاء الراسخة التي تجمع بين العدل والحكمة، بين إقامة البينات وإحقاق الحقوق، وبين الضبط التشريعي والإنصاف الواقعي.
ولما كان القضاء المدني يتناول مسائل الحقوق الخاصة، كالعقود والالتزامات والتصرفات المالية والتوثيق والأمانات والملكية، فإن القرآن الكريم لم يغفل الإشارة إليه، بل وضع له أحكامًا تفصيلية تضمن النزاهة والإنصاف. وحيث إن القاضي هو ميزان الحق بين المتخاصمين، فقد أوصى الله تعالى بحتمية الحكم بالعدل، إذ قال: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ” (النساء: 58). فهذا تكليف إلهي جازم بألّا يحكم القاضي إلا وفق ميزان الحق، لا تأخذه في ذلك لومة لائم، ولا تؤثر عليه شفاعة شافع.
على أن من أخصّ ما يجب أن يتحلى به القاضي المدني: سعة الأفق، والقدرة على استنباط الأحكام من الأدلة غير المباشرة، لا سيما حين تتجلى الحقائق في ثنايا الأقوال، لا في صريحها؛ فكما أن الشعاع الخافت قد يدل على مصدر النور، فإن الكلمة العارضة قد تكشف عن جوهر القضية. وهذا ما تجلى في قصة النبي سليمان، عليه السلام، حين احتكمت إليه امرأتان اختصمتا في نسب طفل، فأمر بقوله: “اقطعوه نصفين”؛ ليختبر صدق ادعاء كل واحدة منهما. فلما جزعت الأم الحقيقية وقالت: “دعوه لها ولا تقطعوه”، علم سليمان، بحكمته، أن الرحمة لا تكون إلا من أمّ صادقة، فأعاد الولد إليها.
وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نستحضر عظمة التشبيه القرآني المعجز، إذ شبّه الله الحق الثابت بالماء النافع الذي يمكث في الأرض، والباطل بالزبد الذي يذهب جفاءً، فقال: “فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ” (الرعد: 17). فكما أن الأمواج تعلو، ويظنها الرائي سيدة البحر، لكنها سرعان ما تزول، ولا يبقى إلا الماء العذب، كذلك الباطل قد يعلو برهة، لكنه لا يلبث أن يتبدد، ويبقى العدل ماثلًا كالماء الصافي في قرار مكين.
وإذا كان التشريع المدني اليوم يقيم وزنه على الإثباتات والبراهين، فإن النبي محمدًا، صلى الله عليه وسلم، سبق إلى وضع قاعدة كلية في القضاء المدني، حين قال: **”البينة على المدعي، واليمين على من أنكر” (حديث صحيح، رواه البيهقي). وهذه القاعدة لا تزال إلى يومنا هذا أساس الفصل في الدعاوى المدنية؛ إذ لا يُقبل ادعاء بغير دليل، ولا يُرفض إنكار إلا بيمين مغلظة. وحيث إن الله قد جعل العدل قوام الحياة، فإنه سبحانه قد نهى عن الهوى في الحكم، فقال: “وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ” (المائدة: 8).
ولئن كان القضاء المدني يرتكز على العقود والتوثيق، فإن القرآن الكريم قد أرسى أصول هذا الباب، تشريعًا وتنفيذًا، فقال في أطول آية نزلت: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَليملل الذي عليه الحق” (البقرة: 282). فهذه الآية تضع أسس الإثبات والتوثيق في العقود المالية، بحيث لا يكون للخصومة سبيل، متى كان العقد مكتوبًا بين طرفين، بوثيقة معتمدة.
على أن من تمام الفصاحة في القرآن أن يضرب الأمثال لما يُحتاج إلى بيانه؛ إذ كيف تُفهم الأمور الدقيقة إلا عبر التشبيه والتصوير البليغ؟ ومن ذلك ما جاء في وصف جدلية الباطل والحق، في قوله تعالى: “وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ” (إبراهيم: 26). فإن القاضي الذي يحيد عن العدل أشبه بشجرة خبيثة، لا جذر لها ولا استقرار؛ إذ سرعان ما تقتلعها رياح الأيام، ليحل مكانها ميزان العدل الذي لا يميل ولا ينكسر.
ولا ريب أن التاريخ الإسلامي حافل بالنماذج التي تجسد القضاء المدني بأبهى صوره؛ فهذا النبي داوود، عليه السلام، لما أتاه خصمان في قضية مدنية تتعلق بالملكية، قال أحدهما: “إن هذا أخي، له تسع وتسعون نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب”، فحكم داوود عليه السلام لصاحب النعجة الواحدة، إذ رأى غلبة القوي على الضعيف. لكن لما تأمل في الأمر، ازداد حرصه على التثبت، فرجع إلى التحقق من جوانب القضية. وهذا يرسخ مبدأ أن العدالة لا تقوم على الظاهر وحده، بل على التحقق والتدقيق.
وبعد، فإذ كان القضاء المدني، في أصوله الحديثة، يعتمد على التوثيق، والبينات، والقواعد التشريعية الدقيقة، فإن هذه الأسس لم تكن بدعًا من الأمر؛ بل هي مبادئ قرآنية راسخة، سبقت إلى بيانها آيات الذكر الحكيم، وأرست أركانها أحكام النبوة الصادقة؛ لتبقى العدالة ميزانًا ثابتًا، لا تميل به الأهواء، ولا تهزه العواصف. فإذا استقام القاضي، استقام القضاء، وإذا فسد القاضي، فسد العدل أجمع. وأي فساد أعظم من أن تُبدّل الموازين، فلا يبقى للحق صاحب، ولا للعدل موضع في دنيا الناس؟