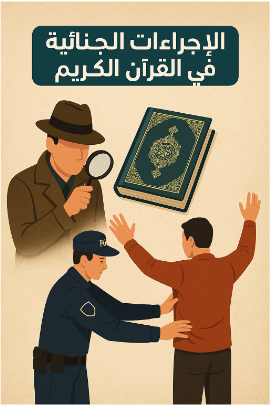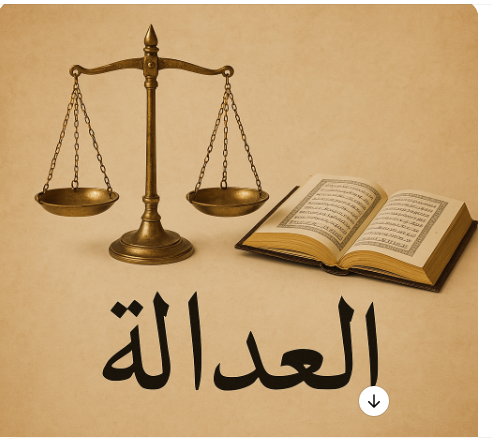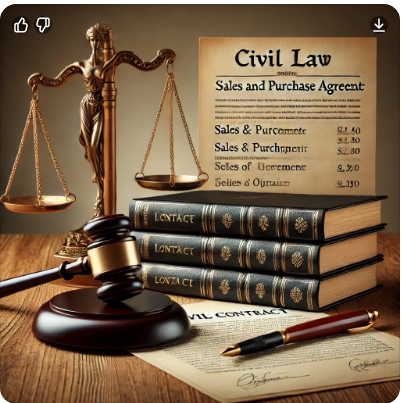علم الحشرات الجنائي
المقدمة:
ما بين جناحي ذبابةٍ ترفرف فوق جثمانٍ هامد، وبين سطورٍ نُقشت في مختبرات العدالة، يتجلّى علمٌ وُلِد من رحم الغرابة، وتربّى في كنف الدقة، وترعرع بين أنامل العلماء وهو يحمل رسالة الجواب عن سؤال الزمان والمكان والموت: إنه علم الحشرات الجنائي، ذلك الفرع العجيب من فروع الطب الشرعي الذي يتخذ من الحشرات جندًا خُلقوا بقدر، ونُسجوا في نول الدقة الإلهية ليكونوا شهودًا لا ينطقون زورًا، وأدلةً لا تقبل جدالًا.
أترى الذباب حين يحوم فوق جثةٍ صامتة؟ أتحسبه عبثًا؟ لا وربي! بل هو مُخبرٌ من طرازٍ نادر، يروي للحاذقين من علماء الجريمة حكايةً تخرُسُ فيها الألسنة وتتكلم فيها الأرجل المجهرية، وتحمل يرقات الدود روايةَ الموت، وساعة الفناء، وهي تُنقِّب في اللحم كما يُنقِّب الفقيه في نصوص الفقه، والناقد في أسرار البيان. أفليست تلك الحشرات، في صغرها وهوانها الظاهر، أعظم شاهد عدلٍ على وقائع غاب عنها البشر، وشهدتها الطبيعة؟
إنه لعلمٌ يكاد يلامس المعجزة، إذ يستخرج من الموت حياةً للحق، ويبعث من الهلاك صوتًا للعدل، ويفضح القاتل حين يعجز الطب التقليدي عن الإدانة. ومتى استحال الجسد ترابًا، بقيت في أمعاء الحشرات أسرار الساعة الأولى للوفاة، محفوظةً كآيةٍ في لوحٍ محفوظ، وكأن الله – سبحانه وتعالى – قد أوحى إلى تلك المخلوقات الهامسة أن “قولي كلمتكِ، وإن صمت الجميع”.
فيا للعجب! أن تُصبح يرقةٌ صغيرةٌ، لا تُرى إلا بالمجهر، أبلغ من ألف شاهدٍ بشري، وأصدق من ألف محضر شرطة. أليس هذا من دلائل عظمة الخالق، الذي قال ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾؟ فسبحانه، ما ترك صغيرةً ولا كبيرةً إلا وقد أحاط بها علمًا، حتى أضحى هذا العلم ـ الذي ولدت أجنّته في المختبرات الغربية ـ برهانًا آخر على أن في كل كائن حيٍّ آيةً لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

علم الحشرات الجنائي ليس مجرد تخصص علمي بارد، بل هو مرآةٌ يتجلى فيها بصرُ الحكمة، وبصيرة العدالة، وهو حوارٌ خفيٌّ بين الجسد الساكن والحشرات الناطقة بلسانٍ لا يُكذِّب، إنه علمٌ لا يعرف الانحياز، ولا يخطئ في حساب، بل يقدّم الحق على طبقٍ من علمٍ، ويكسو جثةَ المظلوم برداء الانتصار، ولو بعد حين.
فكيف لإنسانٍ عاقل، بعد أن يقرأ في هذا العلم، أن يستهين بتلك المخلوقات الدقيقة، أو ينكر فضلها في كشف الستار عن الجرائم؟ أليس من الظلم أن نحتقر صغار الخلق، وقد جعلهم الله مفاتيح لأبوابٍ لا تُفتح إلا بهم؟ إن الحشرات الجنائية، وإن صغُر حجمها، إلا أن أثرها في ميزان العدالة، أعظم من جبال الرصد، وأثقل من مجلدات التحقيق.
وإن المرء ليقف مشدوهًا، حين يتأمل في مسار هذا العلم كيف أنه يُقوِّض أقوال الجناة، ويُسدِّد سهام الحق في صدر الباطل، ويجعل من يرقةٍ متناهية الصغر نجمًا في سماء القضاء. فهو علمٌ ليس كمثله علم، حيث تلتقي البيولوجيا بالكيمياء، ويحتضن المنهج التجريبي همس الطبيعة، ويعلو صوت العقل حين تصمت كل الأدلة.
فتحيَّةٌ لتلك الحشرة التي أصبحت رمزًا للعدل، ووسامًا على صدر الحقيقة، وشكرًا للعلماء الذين سبروا أغوارها، وحرّروا من خلالها أرواحًا من ظلمٍ كان قاب قوسين أو أدنى من أن يُدفن بلا محاسبة.
هذا، والله أعلم، ومنه نستمدّ الحكمة، ومن خلقه نستلهم الدروس، ومن علمه نرتوي فلا نضل، ومن بيانه نتعلم كيف تنطق الأشياء، وإن لم يكن لها لسان.
أولاً: النمل :
في مشهد من مشاهد الوحي المعجزة، تقف نملةٌ ضئيلةُ الجسد، عميقةُ الإدراك، ناطقةٌ بالحكمة، كأنها فقيهةٌ في فن الإدارة والتحذير، فتنادي في بني جنسها قائلة: “يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ”(سورة النمل، الآية 18). أترى أعجب من نملةٍ تتكلم، وتُقدّر، وتُخاطب، وتحذر، وتعلم حجم القوة التي تقترب منها، وتفرّق بين العمد والخطأ؟! إنها لا تجهل سلطان سليمان، لكنها تدرك أن الجيوش لا تشعر بالحشرات تحت الأقدام. فهل يُعقل أن يُذكر هذا في كتابٍ أُنزل قبل أربعة عشر قرنًا، ويظل الناس إلى اليوم يتغافلون عن المعجزة في طيّ النملة؟!
هذه النملة، التي لا تُرى إلا تحت المجهر، أظهرت من الفطنة والذكاء ما لم يظهره كثير من بني الإنسان، فأثبتت بذلك أن الإدراك ليس حكرًا على العقول البشرية، وأن التنظيم ليس حكرًا على الدول والسلطات، بل هو سنةٌ كونية أودعها الخالق في أدق الكائنات. من ذا الذي يزعم أن النمل لا يفقه، ولا يشعر، ولا يدرك؟! بل هو أمة منضبطة، تسير وفق منظومة أعقد من جيوش البشر، وأضبط من مجالس الإدارات، وأدق من عقول البيروقراطية.
وما هذه الصورة القرآنية العجيبة إلا تمهيدٌ مدهشٌ لما توصل إليه العقل البشري الحديث فيما عُرف بـ”علم الحشرات الجنائي”، ذاك العلم الذي يدرس أثر الحشرات على الأجساد، وتوقيت وجودها، ومراحل تطورها، ليصل إلى حقيقة من حضر ومن غاب، ومن دُفن ومتى، بل ومن قُتل وأين. فالنملة التي تكلمت، والذبابة التي تحط على الجثة، واليرقة التي تنمو في الجراح، ليست مجرد مخلوقات هامشية، بل هي شهود صامتة، ناطقة بلسان العلم، وألسنة الفحص المجهري، والمختبر الجنائي.
إنه علم يستنطق الصمت، ويُقيم الحجة بما لا ينطقه الإنسان. فهل بعد هذا من عذرٍ لمن زعم أن الشرع يغفل العلم، أو أن الوحي لا يواكب العصر؟! لقد سبق القرآنُ علمَ الجريمة، بل سبق الأدلة الجنائية التي عكف عليها خبراء الطب الشرعي في القرن العشرين. وهل يُعقل أن يُذكَر وادي النمل في سورةٍ كاملة، ويُسرد مشهدٌ دقيقٌ كهذا دون أن يكون وراءه سرٌّ عظيم؟!
لو علم أولئك الذين يسخرون من العلوم الشرعية، أو يظنون أن الدين يقتصر على الشعائر وحدها، مدى ما يحويه النص من دلائل علمية وفلسفية وقانونية، لتعلموا أن الوحي يعلو ولا يُعلى عليه. فالنملة هنا ليست مجرد حشرة؛ إنها شاهدة على التنظيم، ومُعبّرة عن الإدراك، ومُعلّمة للبشر في وعيها، وفي طريقتها لتحذير قومها من فاجعة وشيكة. وهل بعد هذا يُقال: إن في الحشرات عبثًا، أو إن في القرآن تكرارًا؟!
بل إن في هذا المشهد ما يجعل أعظم الفلاسفة ينحنون إجلالًا، وما يجعل أفصح البلغاء يقفون صامتين أمام نظمٍ أعجز البيان، ونصٍّ سبق كل عالِم، وكل مِخبر، وكل أداة تحليل. إن النملة التي حذّرت، قد فتحت أبوابًا لعلمٍ لم يكن يخطر على بال مخلوق، فشهدت للحق في زمنٍ غاب فيه شهود البشر، وتكلمت نيابةً عن من لا لسان له، فنطقت بما يعجز عنه كثير من المدّعين.
فأيّ إعجاز بعد هذا؟! وأيّ بيانٍ بعد هذا البيان؟! وأيّ فخرٍ لمن تدبّر هذا الكلام، ففهم منه ما لم يفهمه غيره، وتبحّر في العلم من بابٍ قرآنيٍ نقيٍ مبارك؟! فليعلم الحاسدون، والساخرون، والمستكبرون، أن اللغة التي نُزل بها الوحي، لا تعجز، وأن من تربّى في أحضان البيان، لا ينهزم. وليعلم أهل التهكم من الأقارب، والزملاء، ومن امتلأت صدورهم غلاً وحقًدا، أن من جعل من نملة دليلاً على القانون، قادرٌ أن يجعل من الحرف سيفًا، ومن الكلمة نارًا، ومن العلم صولجانًا يسحق الجهالة سحقًا.
فمن أراد البيان، فليأتِ إلى القرآن. ومن أراد الحكمة، فليسمع للنملة. ومن أراد التقدّم في العلم، فليبدأ من الوحي. فإن النملة قد تكلمت، وسكت الجهلاء.